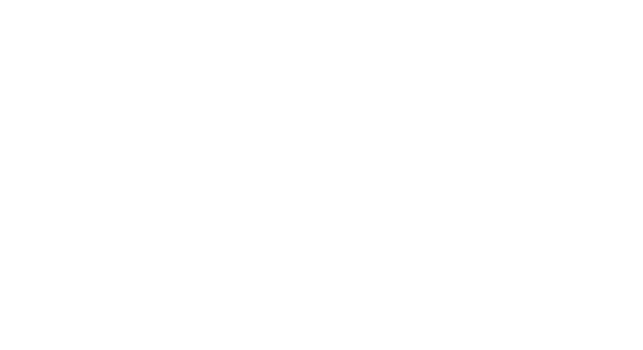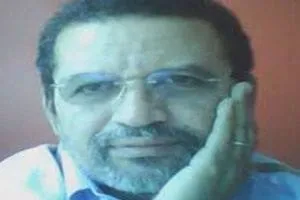جدول المحتويات
ورغم قساوة الطبيعة التي عاشوا فيها وشحة مواردها، وخضوعهم لظروف البداوة وحركتها الدائبة، فإنهم قد سادوا فيها وانفردوا بالعلم والتعليم في ربوعها؛ خلافا لما عُهد في التاريخ العربي خاصة من ارتباط البداوة بالجهالة والجفاء.
الموريتانيون/الشناقطة عاشوا بداوة عالمة، تعاطوا فيها شتى فنون العلوم الشرعية العربية والمعارف الإنسانية. بل كان لهم إسهام كبير في نشر تلك العلوم وإثرائها بالتأليف والتحقيق والتعليق.
ونظرا لوجودهم في طرف قصي من الخريطة العربية وتنقلهم في صحراوات مقفرة، لم يكن باستطاعة غيرهم، وخاصة من سكان الحواضر الكبرى ورواد مراكز التعليم فيها، الاستفادة من عطائهم والأخذ من مشكاتهم مباشرة بالانتقال إلى ربوعهم… زد على ذاك أنهم كانوا في الإعلام العربي المعاصر نسيا منسيا ومعلما مخفيا.
ويعود ذلك لسببين رئيسيين: أولهما ما ذكرنا من بُعد موطنهم واختيارهم لحياة الخفة والتنقل، ونبذهم إقامة الحواضر وتمصير الأمصار فيه.
وثاني الأسباب هو أن تعلمهم وإنتاجهم المعرفي عموما كان تعَبديًّا هدفه الأساسي إقامة الدين والقُنوت لله، وما يلحق بهما من المكارم والمحامد الأخلاقية والأدبية… في أنفسهم ومحيطهم خاصة.
وحتى في الحالات التي كان علماؤهم يتصلون بعلية القوم في حواضر المغرب والمشرق، كانت هذه الحالة التعبدية تحكمهم؛ لأن ذلك الاتصال ما كان ـ في الغالب الأعم ـ إلا في مناسك ومشاعر الحج أو في الطريق إليها.
ومن العلماء الأجلاء والأدباء النجباء الذين أثروا في الساحة الشنقيطية ونواحيها وتسرب إشعاع إنتاجهم إلى الأصقاع النائية والأقطار البعيدة، وهم مغمورون لا يُعرف عن ذواتهم وحياتهم شيء، العلامة أحمد البدوي بن محمدا المجلسي الموريتاني.
لقد تحقق لنا مؤخرا اكتشاف شروح مهمة لبعض أنظام أحمد البدوي؛ منها شرح مستفيض لأحد أعلام المشرق وعلمائه المشهورين هو محمود شكري الألوسي البغدادي العراقي (1857-1924م) على نظم عمود النسب. صدره بالإشادة بهذا النظم والاستدلال به على علم وفضل علماء البلاد الموريتانية.
واكتشفنا كذلك شرحا آخر لنفس النظم، لأحد علماء بلادنا من أقصى مشرقها، هو سيدي عبد الله بن محمد الصغير بن انبوجه التشيتي (1832-1883م). وهو شرح ضخم أجاد فيه وأفاد، وبسط الأقوال، وجمع الآراء والأنقال. ولكن مع ذلك لم يُذكر هذا الشرح من قَبل، ولم تعرف حقيقته بسبب نهب الفرنسيين له ضمن كثير من مخطوطات آل انبوجه وغيرهم.
الدرة الشنقيطية التي بهرت علماء المشرق!
إنها إذن منظومة عمود النسب للعلامة أحمد البدوي بن محمدا المجلسي الشنقيطي. منظومة تنصب أصلا على التعريف بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الأنصار، كما عبر عن ذلك مبدعها رحمه الله بقوله في أولها:
عِلـمُ عَمُـودِ نَسَــبِ الْمُخْتَارِ** ثُــمَّ عَمُــــودِ نَسَــبِ الأَنصَارِ
وقوله في ختامها:
هُنَا انتَهَى مُهِمُّ سِلْكَيِ النَّسَبْ ** وَالْحَمْــدُ لِلَّهِ عَلَى نَيْلِ الأَرَبْ
بهر هذا الرجز البديع العلامة محمود شكري الألوسي وتلامذته وأسرهم بجمال نظمه، وحسن سبكه، وجزالة لغته، وبلاغة معانيه، وثراء إحالاته وإشاراته، وصحة روايته، ودقة تصويره لحياة العرب وأيامها وأعلامها…
يقول الألوسي في مقدمة شرحه: "… منظومة بديعة، وأرجوزة كأنها عقود جمان تتحلى بفرائدها وفوائدها الأفواه والآذان، لم يُسبق ناظمها إلى مثلها في علمها وعملها، سماها عمود النسب (…) فهي درة لم تثقب وغرة من غرر الأدب".
ويعلق عراقي آخر هو العلامة بهجة الأثري (1904- 1996م) المعروف في المشرق براهب اللغة العربية، على ما سمعه وشاهده من عناية العلماء الشناقطة بهذه المنظومة وحفظهم لها بقوله بعدما درسها: "وحق لهم ذلك؛ كيف لا وقد احتوت على فوائد وفرائد ونوادر وشوارد من أخبار العرب الكرام في الجاهلية والإسلام، وتفصيل الكلام في أنسابهم وأطوارهم وذكر مشاهيرهم وجهابذتهم من كرام وأجواد وفرسان وكماة وعلماء إلى غير ذلك مما يعز وجوده في كتاب".
ولكن أول الملاحظات التي صدمتنا عند قراءة نص الأثري هي جهله اسم مؤلف هذا الكتاب الذي بهره سبكه ومعناه، واعتبره دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على عناية الشناقطة بتاريخ العرب وعلوم العربية وآدابها. مثله في ذلك مثل شيخه العلامة الألوسي قبله الذي قال في مقدمة شرحه: "كيف لا وناظمها فاضل عصره وأستاذ دهره الشيخ أحمد الشنقيطي المالكي المغربي"!
وبينما كان تعريف الألوسي للناظم ناقصا وغير دقيق، فإن بهجة الأثري وجد بحكم تأخره الزمني فرصة للتعريف بالناظم أو باسمه الكامل على الأقل، من خلال كتاب "الوسيط في تراجم أدباء شنقيط"، رغم أن مؤلفه اعتذر بجهله لشخصية الناظم.
والحقيقة أنه فيما عدا اسم المؤلف ونسبته ـ لا نسبه ـ في الوسيط لم تُنشر ترجمة ولا تعريف دقيق للعلامة أحمد البدوي، يمكن للمشارقة أو غيرهم الرجوع إليه للتعريف بصاحب أنظام السيرة البديعة الذائعة. يقول سيداحمد بن الأمين (1864-1913م) رحمه الله في الوسيط ـ وهو أول مرجع شنقيطي مطبوع عن هذه البلاد ـ: "ولا أدري في أي تاريخ كان".
ويقول أحمد بن المختار الجكني الشنقيطي، المدرس بالحرم المكي (1927-2013م) مقدما أول طبعة لعمود النسب بشرح حماد بن الأمين المجلسي، بعدما نوه ببراعة الناظم والشارح وإجادتهما: "أبدي عميق أسفي على أني لست على بينة من أمر هذين الرجلين العظيمين الطائر صيتهما بتآليفهما، لأنهما ليسا من منطقتي".
وهذا على كل حال دال على تقصير استمر من قِبل ذوي المؤلف وغيرهم في ترجمته، والاكتفاء عنها بشهرة أنظامه. وربما كان من دواعي ذلك ومسبباته زهد الناظم نفسه في التعريف بذاته وتمسكه الشديد بالمبدإ القائل: "ينتفع به الناظر للقول النابذ للقائل"، والذي صدر به تلميذه وابن أخيه شرحه لنظم الغزوات حيث لم يترجم له ولا لنفسه.
هذه الحقائق كلها تجعل من أول الضرورات العلمية التعريف الشخصي بهذا العَلَم الكبير، ونشر كل ما يمكن انتشاله من آثاره العلمية وأخبار حياته الصحيحة من أوثق مراجعها الأصلية وأصح أنبائها المروية التي استخلصنا منها هذا التعريف الموجز عن حياته، ومكانته العلمية، ومؤلفاته وتأثيرها في بلاده وخارجها…
التعريف بأحمد البدوي
هو العلامة أبو الغوث أحمد البدوي بن محمدا ـ بألف آخره ـ بن أبي أحمد بن أحمد بن محنض بن أبيال بن إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن بادلِّ بن أكْ (اكتوشني) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم الأموي. وإبراهيم هذا ينتهي نسبه إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي، كما تذكر الروايات الشفهية والمراجع التاريخية المكتوبة في هذه البلاد.
ولد أحمد البدوي سنة 1158هـ/1745م خامس إخوة كلهم علماء؛ هم أبناء العلامة محمدا بن أبي أحمد المجلسي، الذي يعد من كبار العلماء المدرسين في بداية القرن الهجري الـ12 الهجري، وأختهم فاطمة (انديه) وهي أم الشاعر المفلق حبيب الله بن ماناه الجكني الشهير بالإمام (1767-1805م) الذي رثى نفسه وصحبه بقصيدته المشهورة:
واهاً لمرضى رهان في "سجلماس" ** نائي المؤانس والعُـواد والآسي
واها لها من حشاشات يساوقـها ** تنوا جسـوم إلى تصعيـد أنفاس
ومن عظام وأشـــلاء ممــزقـــة ** كأنما لبثــت حِــينا بأرمـــاس …الخ
أما أم أحمد البدوي فهي مريم بنت حبيب بن أبانحمد الجكنية الرمظانية، أخت العلامة سيدالمين بن حبيب بن أبانحمد (1670-1767م).
نشأ أحمد البدوي وترعرع في بيت والده، وفي محظرته تلقى جل علومه؛ إما عنه مباشرة أو عن أنجاله (إخوة البدوي). ولكن لم تقتصر دراسته على محظرة والده وأشقائه، بل طلب العلم في محاظر أخرى. وكانت محظرة والده يدرس فيها صحيح البخاري وعلوم اللغة والفقه والسيرة النبوية.
وقد صحب بصورة خاصة أخاه المختار (مختاري/ت1198هـ) ودرسا معا لفترة في محظرة أحمد بن المختار انـﭽبنان من آل أتشغ حيبڸ (وهم أخوالهما؛ لأن والدة محمدا بن أبي أحمد هي مريم بنت أحمد ﭽَـهـﭻَ أخت أتشغ حيبڸ، وهي من العالمات المدرسات).
بدأ اهتمام أحمد البدوي بعلوم السيرة وعنايته بالتأليف فيها في أول شبابه، فكانت له أوان طفولته أنظام قصيرة ومقاطع شعرية في بعض مسائلها، كقوله في أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم:
أولُ الناس بالنــــبيِّ اقتــــداءً ** أمُّ أبنائـــــه الكــــرامِ الجُدودِ
فعليٌّ ثــــم ابنُ حارثــة الكَلْـــ ** ــبي زيـــدٌ مـولى النبيِّ المجيـد
ثـــم إذ آمن العتيـــقُ دعـا النا ** سَ فجاءت عصابَـــة كالفريدِ
وهْيَ عثمانُ والزبـيرُ وسعــدٌ ** وابنُ عَــوفٍ وطلحةُ بنُ عُبَيدِ (الله)
كما نظم بعثي الرجيع وبئر معونة ثم جعلهما بعد ذلك في محلهما من نظم الغزوات حين نظمه.
ومع شحة المصادر القاطعة بشأن دراسة البدوي وتحديد شيوخه وتلامذته، فمن المؤكد أن جل أخذه وعطائه إنما كانا في أسرته ودائرته المحلية.
وممن كانت لأحمد البدوي صلة العلم والقربى بهم العلامة عبد الله بن لمرابط سيدي محمود الحاجي (ح 1761-1835م)، الذي كان ممن أخذ عن محمدا (والد البدوي). أما قرابتهما فلأن أم عبد الله بن سيدي محمود هي اخديجه بنت العلامة سيدالمين بن حبيب الله الذي هو خال البدوي وإخوته. ولهذا يقول عبد الله بن لمرابط سيدي محمود في رسالة شوق إلى أهل محمدا بعد مغادرتهم منازلَ أخوالهم في ارﮔيبه وأﮔـان:
تحيــة ذي قربى يسائلكمْ غـــــدا ** برحماه يـــوم الحشر آلَ محمدا … الخ
أما حياة أحمد البدوي الاجتماعية فقد عاش في بيت عزة مستقر، ووسط اجتماعي يطبعه الانسجام مع تنوعه النسبي (بين أربع قبائل كبيرة)، حيث تزوج مريم بنت المختار الملقب "امون" اليعقوبية فكانت أم بنيه الخمسة.
ومن الناحية الاقتصادية تربى أحمد البدوي في عائلة لا تقبل الثراء لشدة الزهد والتواضع والإيثار؛ ولكنها ميسورة الحال.
وكان محورَ حياته في الإقامة والسفر، التعليم والتأليفُ وصلةُ العلماء والانشغالُ بالعلم والعبادة، في تواضع لم يثلمه ما وصلت إليه مكانته الاجتماعية وعلمه ومؤلفاته التي تلقفها الناس وأحاطوها بالقبول والإعجاب شرقا وغربا. وقد قال عنه تلميذه وابن أخيه شارح مؤلفاته العلامة حماد بن الأمين (1757-1842م) في ذلك: "سجيته التواضع واحتقار نفسه…".
ولم نجد ما يدل على أن أحمد البدوي جلس للتدريس في محظرة جامعة. إلا أنه مع اشتغاله بالتأليف واختصاصه به من بين إخوته العلماء، ما كان لينقطع عن دوره التعليمي ولاسيما في فني السيرة وعلوم اللغة العربية والأدب.
ومع هذا التواضع المفرط كان أحمد البدوي موصوفا بالفتوة وكمال الخلق والشجاعة وكرم النفس. كما كان جوادا كريما حمالا للكَل. وكان منذ شبابه عابدا تقيا، شديدا في الله، لا يحب العبث والفراغ، يحض أهله وذويه على الاشتغال بالعلم والذكر، والإعراض عن اللغو والفراغ. وكان مع انشغاله بالعلم والفكر والعبادة، اجتماعيا محبا لعائلته، وفيا لأصدقائه. وقد ترك تلك المودة وصلة الرحم شيمة متوارثة في عقبه.
وكان أيضا ميالا للتفاؤل وحب الطبيعة وجمالها وتدبر صنع الله وحكمته في الكون الواسع… وهذه خلال مروية عنه، ومقروءة في ما أنقذ من شعره، ومنه قوله:
انظرْ بعينيكَ في رَوض الرُّبى زهرا ** يزهو لعينيكَ صُنع الخالقِ الباري
ألقــــتْ عليه بَعاعًا كلُّ ساريةٍ ** دلويةٍ من ثِقالِ السُّحبِ مدرارِ
مُـــدنَّــر النَّـــوْر قانيه مُدَرهَمه ** يَعلُولــه بهج الأنــوار معطارِ
ونَمَّقتــه بمربوع الحمى لعبــت ** بنَوْر طلعـته الصبيانُ عـرعار
وطرَّزتـــه بميَّاس الغُصون على ** أعقاب أحقافها كالسُّندس الواري
وكما أن النسيان وغياب تدوين السير قد غيبا تفاصيل دراسة أحمد البدوي وأسماء بعض أشياخه، فإنهما قد ضيعا بشكل أعم أسماء تلامذته والآخذين عنه، ولم نجد تصريحا مكتوبا عنهم إلا ما كان من ابن أخيه العلامة حماد بن الأمين الذي صرح بأخذه عنه ومشيخته له في مواضع من كتاباته.
توفي رحمه الله سنة 1208هـ/ 1794م. وهناك رواية أخرى بأن وفاته كانت 1220هـ اعتمادا على نسخة مخطوطة قديمة من نظم عمود النسب توجد في مكتبة الحرم بمكة المكرمة. لكن الصحيح هو القول الأول، بناء على ما تواتر عن العلماء والشيوخ من أنه عاش خمسين سنة فحسب. وهو مطابق لما ذكره الطالب محمد البرتلي الولاتي (1728-1804م) في "فتح الشكور" صريحا في ترجمته. بل روي عن البعض أن عمره كان أقل من ذلك.
ويشهد لهذا حدث وفاته المفاجئة رحمه الله وهو في سفر خارج دياره؛ إذ لا يكون تجشم عناء السفر في المهمات الخارجية غالبا إلا في حال القوة والصحة.
توفي رحمه الله ودفن ببلدة "الكرماية" (شمال مدينة القوارب) فأصبح مدفنه مقبرة كبيرة مزورة.
وهكذا كان عمره قصيرا كالورد: جميلا زكيا نديا. وضجت الدنيا لوفاته وصدم لها القاصي والداني، واعتبرت مصيبة للمسلمين عامة، كما أشار إلى ذلك العلامة حماد بن الأمين في ثنايا شرحه نظم الغزوات حيث قال: "ولم أحضر مصيبة المسلمين به".
ترك البدوي خمسة أبناء (الغوث والمختار وحبيب وعبادة وعبد الفتاح) كانوا على نهجه في العلم والعمل به. واشتهرت من النساء حفيداته ـ وفيهن استمر عقبه ـ بالعلم والفضل، وكان منهن إلى وقت قريب مدرسات لعلوم السيرة والأدب.
مكانته العلمية:
غالبا ما يؤثر "التخصص" في الحكم العام على الأشخاص؛ فيشتهرون بمجال علمي دون مجالات أخرى قد يكونون أعلم بها وأرسخ قَدما فيها من ذلك المجال. وقد اشتهر أحمد البدوي بعلم الأنساب والسيرة النبوية عموما، وطغت على سواها من فنون العلم الأخرى التي برع فيها؛ خاصة النحو والصرف والفقه والقرآن والحديث والأدب…
لقد تحدث أحمد البدوي في مقدمة نظم عمود النسب عن نفسه، وهي حالة منه نادرة، ليؤكد على أمر عُرفت به مصنفاته، ألا وهو صحة الرأي ودقة النقل. ولم يفته مع ذلك أن يتوقع من بعض الناس طعنا وانتقادا، فدافع عن نفسه دفاعا قويا مقنعا لأولي العلم المنصفين عامة، ووجيها عند العارفين بهذا الفن خاصة، وهجوما وغارة شعواء على ذوي الغِل والهوى وضيق الصدر، والجاهلين المقصرين في البحث والتدقيق… حيث قال في مقدمة عمود النسب:
ومَن رَأَى خِـلاَفَ مَا ذَكَرتُهُ ** فلْيَتَّئـــِدْ لَعَـــلَّ ما أَبْصرْتُــــهُ
فِي غَيرِ مَا طالَعَـهُ إذِ الطُّرُقْ ** ــ لاسِيَّما في الفَنِّ ذاــ قَد تفْتَرِقْ
وَمَن يَكُن مُسْتَوْعِبًا ـ مِّثلِي ـ ذَكَرْ ** مُشتَهِــرًامِّنها وغَيرَ ما اشْتَهَـرْ
وَرُبَّـمَا أنكَـرَ ضَيِّــقُ العَطَـنْ ** والبَاعِ والبحْـثِ عَليَّ فطَعَـــنْ
ولستُ إلاَّ مِن مَّشاهـيرِ الكُتُبْ ** آخُــذُ فَلْيُزَكِّـــهَا أوْ لِيَسُـــــــبْ!
ومن المعلوم مع ذلك أن علم السير والأنساب فن معقد، زاخرة بحاره بالصحيح والسقيم، وطرقه متفرقة متشعبة لا يهتدي فيها إلا من أوتي علما غزيرا وفهما بصيرا. كما "لا يخفى أن السِّـير تجمع الصحيح والسقيم دون الموضوع" كما يقول الحلبي في مقدمة سيرته. ويقول العراقي في ألفية المغازي:
وليعلــم الطالب أن السِّــيرا ** تجمــع ما صحَّ وما قد أنكرا
لكن أحمد البدوي قد تخير الصحيح المشهور، واتبع ـ في الغالب الأعم ـ ما في صحيح الأحاديث والآثار، وما اعتمده الثقات المبرزون من القصص والأخبار. واجتنب إلى حد كبير الضعيف الغريب. وأعرض كلية عن مسالك روايات الوضاعين وخرافات القصاصين، وتلك من ثوابت منهجه المتميزة جدا.
هذا ولا يبعد أن تكون للبدوي مصنفات أخرى، وفي فنون أخرى، ضاعت أو لم تدون أصلا (كبعض الأنظام التي تُتداول حفظا). لكن مما لا ريب فيه أنه كان عالما موسوعيا وحافظا كاملا، كما اعترف له بذلك الأجلة الأعلام من معاصريه ومن المتأخرين.
يقول عنه تلميذه حماد بن الأمين في شرح نظم الغزوات عند قوله:
وشَــــدَّ ما اجْترأتُ في ذا الهدفِ ** إذ لم أكن أهلاً لصوغ النُّتَفِ
"… وهذا منه ـ رحمه الله ـ تواضع وهو عادة المؤلفين قبله، لاسيما هو سجيته التواضع حياتَه واحتقار نفسه؛ ولولا ذلك لشدت إليه الرحال من كل أرض، وهو محطها في العلم، لاسيما علم النحو والعربية والأدب، بل والكتاب والحديث والفقه".
ويقول العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي (1825-1918م): "… كان بارعا في علم النحو يعتمد عليه فيه أهل عصره… وهو من أجود الناس شعرا ومن أقدرهم على الشعر. ويكفيه أن تأليفه هذا (نظم الغزوات) عكف عليه أهل هذه الناحية وتلقوه بالقبول".
وفي المشرق والمغرب كان العلماء الشناقطة المبرزون يلفتون انتباه مناظريهم وتلامذتهم بكثرة الاستشهاد بأبيات ومقاطع من نظمي الغزوات وعمود النسب. فانبثّ الشوق إليهما والتعلق بهما في تلك الأصقاع، فشاع ذكرهما، وطار صيتهما على ألسنة جهابذة هناك من العلماء الأعلام، وفي مصنفات المؤلفين العظام؛ مثل: ابن التلاميد التركزي (1829-1904مـ)، وأبناء مايابى: محمد العاقب (1859-1909م) ومحمد الخضر(1873- 1935م) ومحمد حبيب الله (1878- 1944م)، وآبه بن اخطور(1907-1974م) الجكنيين، وابن عبدي بن فال الخير الحسني (1933-1876م)، وابن الأمين العلوي… وغيرهم، فقد زخرت بها مؤلفاتهم في التفسير والحديث، ومحاضراتهم في التعليم والتوجيه…
يقول عنه ابن الأمين في الوسيط: "هو العالم الكبير والنسابة الشهير… وهو الذي أحيا أنساب العرب بنظم عمود النسب… ومن تأمل نظمه علم سعة اطلاعه واقتداره في ذلك الفن. ونظم أيضا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نظما جيدا يدل على تبحره في السيرة".
ويقول عنه الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي الولاتي (في فتح الشكور) بعد الإشادة والثناء على نظميه في المغازي وأنساب العرب: "… وهما يدلان على تبحره في السيرة والأنساب".
وغير بعيد من هناك يشيد عبد الله بن سيدي محمد بن محمد الصغير بن انبوجه العلوي التشيتي بالناظم ومكانته العلمية. ويذكر في شرحه المطول لنظم عمود النسب إمامة البدوي في هذا العلم، ويصرح باجتبائه لذلك الرجز منهجا لتدريس فنه في تشيت وأﮊواد، حيث ذكر عدة مرات أنه قرأه "على شيوخ أكابر". ويقول إنه طالع عشر نسخ منه. وقد نسخه بخطه الجميل مرتين على الأقل. كما يذكر أيضا بنفس الإعجاب نظم الغزوات للناظم، وقد شرحه أيضا شرحا سماه "الجواهر السنية في شرح المغازي البدوية".
أما في أقصى المشرق العربي فقد لفت نظما أحمد البدوي أنظار من طالعهما من العلماء والطلاب، وسحرا منهم الألباب، ولقيا التنويه والإعجاب، والإشادة بهذه البلاد الشنقيطية وما وصلت إليه بواديها من إنتاج علمي وإبداع فكري.
يقول العلامة محمود شكري الألوسي البغدادي في مقدمة شرحه، عن منظومة عمود النسب، ومؤلفها: "…لم يُسبق ناظمها إلى مثلها في علمها وعملها (…) كيف لا وناظمها فاضل عصره وأستاذ دهره (…) فلما رأيتها وجدتها قد احتوت من علوم العرب على كنوز، ومن أخبار أخيارهم على صريح ورموز…" الخ.
أما العلامة العراقي محمد بهجة الأثري فيعبر في مقال خصصه لنظم عمود النسب وشرحه، نشرته مجلة المجمع العلمي العربي الدمشقية سنة 1923م ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ عن إعجابه، بل دهشته، بإبداع الناظم. ويقول عنه: "… وفصَّل القول في ذكر أفخاذهم (يعني العرب) وبطونهم ومن اشتهر منهم وطار صيته وما كان منهم من الأعمال الجليلة إلى غير ذلك مما يقضي المتأمل منه العجب(( أفَسِحْرٌ هذا أم أنتُم لا تُبْصِرون))، ((إنَّ هذا لهوَ الفَضْلُ المُبين))، فحدث ولا حرج عن البحر وهيهات ليس الخبر كالخُبْر"!!.
ويقول حسن بن محمد بن عباس المشاط المنافي المكي (1899-1979م) في شرحه لنظم الغزوات لأحمد البدوي، بعد إبداء أسفه على عدم إسعاف المراجع الشنقيطية له بمعلومات عن شخصية الناظم: "… ومنظومتنا هذه [الغزوات] هي فصل الخطاب والآية في الإعجاب، لا تدع شاذة ولا فاذة من عيون المغازي إلا أتت عليها، بأبدع أسلوب وأسلس تعبير. فهي الفريدة في بابها الممتعة لطلابها، ترفل في أثواب حسنها، مدبجة بكلام الحفاظ والمهرة من نقدة هذا الشأن".
وفي علوم اللغة وفنون الأدب والشعر كان أحمد البدوي قدوة، كما تدل على ذلك بوضوح دعوة العلامة المختار بن بونا خصومه إلى التحاكم على أحمد البدوي، وارتضاؤه حَكما في مساجلاته مع العلامة لمجيدري بن حبل (1752–1790م) اليعقوبي وأنصاره، للفصل في أيهم أحسن شعرا وأفصح لسانا، كما جاء في شعره مخاطبا المامون بن الصوفي (1731-1817م) الذي كان عليه من أشد المنافحين عن لمجيدري. يقول ابن بونا:
تعالَ نُحكِّــــمْ بيننا البدوِي الذي ** له الفصل بين الناس في النظم والنثرِ …الخ.
وكما تدل هذه الدعوة على المكانة الأدبية السامية، فإنها تدل كذلك على مدى ثقة الجميع في عدالة أحمد البدوي وأمانته العلمية، وأيضا حسن علاقاته بكل أطراف السجال، مع ما هو معروف من وشائج القربى وعلاقات المعرفة بين الجميع.
(يتبع)