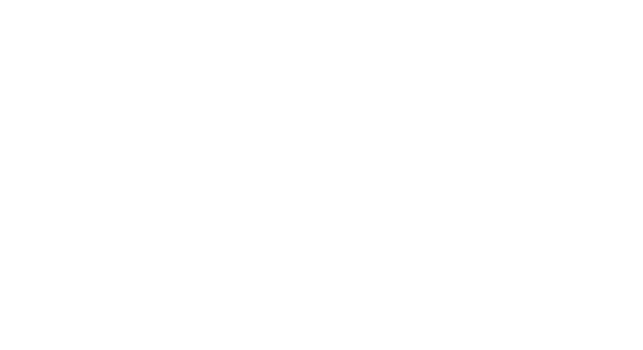جدول المحتويات
منذ أكثر من مئة وخمسةٍ وعشرين عامًا على انطلاق جائزة نوبل في الآداب سنة 1901، لم يفز بها سوى كاتب عربي واحد يكتب بالعربية، هو نجيب محفوظ سنة 1988. حدثٌ استثنائي، لكنه ظل وحيدًا في سجلٍ طويل تتجاور فيه أسماء من مختلف اللغات والحضارات. وبينما توزعت الجائزة بين كتاب اللغة الإنجليزية (نحو 30%) والفرنسية (قرابة 15%) والألمانية والإسبانية والإسكندنافية، ظل الأدب العربي ينتظر اعترافًا مستحقًا يوازي عمقه التاريخي وجمال لغته وغزارة إبداعه.
أولاً: خريطة الجوائز والتمثيل اللغوي
تشير الدراسات المقارنة إلى أن جائزة نوبل في الآداب تعكس – جزئيًا – ميزان القوى الثقافية في العالم. فحوالي 70% من الفائزين كتبوا بلغات أوروبية كبرى، ما يعكس هيمنة المركز الغربي في التقييم الأدبي والمعايير الجمالية.
الإنجليزية تتصدر القائمة بـأكثر من 30 فائزًا، تليها الفرنسية بـ15، ثم الألمانية بـ14، والإسبانية بـ11، في حين أن لغات آسيوية وإفريقية كالعربية والسواحلية والفارسية نالت حضورًا هامشيًا، رغم ثراء إنتاجها.
وقد بيّنت دراسات مثل أبحاث “غراهام هوغز” و”كلود سيمون” و”جيوفاني زيناتي” أن لجان نوبل تميل – من حيث الوعي أو اللاوعي – إلى منح الجائزة لأدب قريب من الفضاء الثقافي الغربي، لغويًا وفكريًا.
ثانيًا: بين الترجمة والاعتراف
يرى النقاد العرب والأجانب على السواء أن أحد الأسباب الجوهرية لغياب الأدب العربي عن الجوائز العالمية هو ضعف حركة الترجمة المنتظمة والمنهجية.
فاللغة العربية، رغم أنها من أكثر لغات العالم انتشارًا (يتحدثها أكثر من 400 مليون إنسان)، تعاني من حاجز التلقي الغربي بسبب قلة الترجمات الجيدة.
وقد لاحظت الباحثة السويدية “آنا باكمان” في دراسة منشورة سنة 2021 أن الأعمال العربية التي تصل إلى القارئ الغربي تمر غالبًا عبر ترجمات إنجليزية رديئة، أو عبر انتقاء لا يمثل روح الأدب العربي الحديث.
إن نجيب محفوظ نفسه لم يُعرف عالميًا إلا بعد أن ترجمت أعماله إلى الإنجليزية بجهود المستشرق البريطاني دينيس جونسون ديفيز. فهل يحتاج الأدب العربي دومًا إلى وسيط ليُسمع صوته؟
ثالثًا: السياسة والتمثيل الثقافي
كثير من الدراسات، خصوصًا تلك التي أنجزها باحثون في الأنثروبولوجيا الثقافية، تذهب إلى أن نوبل ليست مجرد تقدير أدبي، بل خطابٌ سياسي – ثقافي.
فالأدب الغربي يُكافأ حين يعكس “القيم الإنسانية” وفق الرؤية الأوروبية، بينما يُقرأ الأدب العربي غالبًا من زاوية “الشرق والآخر”، كما وصفها إدوارد سعيد في “الاستشراق“.
إن حضور الأدب العربي في الجوائز العالمية ظل مرهونًا إما بالبعد الفولكلوري، أو بتصوير العالم العربي كفضاء للتوتر والغرابة، لا كعالم إنساني متكامل.
من هنا تتجدد الأسئلة: لماذا لا يُكافأ محمود درويش، أو الطيب صالح، أو عبد الرحمن منيف، أو أمين معلوف؟ وهل لأنهم لم يكتبوا “بالنحو الذي يفهمه الغرب”؟
رابعًا: اللغة كأفق جمالي لا كعائق
اللغة العربية ليست مجرد وسيلة، بل كيان جمالي حي.
في شعرها تتقاطع البلاغة والرمز والموسيقى، وفي سردها ينبض العمق الوجودي والفلسفي، من “المقامات” إلى “الرواية الحديثة“.
وقد أظهرت دراسات لجامعات أوروبية وأمريكية (منها جامعة أوكسفورد وجامعة هارفارد) اهتمامًا متزايدًا بخصوصيات السرد العربي المعاصر، مثل روايات واسيني الأعرج، إلياس خوري، إبراهيم الكوني، وهدى بركات، التي تستثمر الذاكرة، الصحراء، والمنفى في بناء رؤى إنسانية كونية.
لكن ما تزال لجان الجوائز الكبرى تنظر إلى العربية كلغة “محلية”، وليست لغة كونية للمعنى. وهذا ظلم جمالي قبل أن يكون ظلمًا ثقافيًا.
خامسًا: نحو إعادة التوازن الرمزي
إن الأدب العربي اليوم يملك كل مقومات العالمية:
– تجارب سردية متقدمة توظف تقنيات ما بعد الحداثة.
– أصوات شعرية جديدة تخاطب الوجود الإنساني بمعناه الكوني.
– نقد ثقافي عربي متجدد يعيد تعريف علاقة الشرق بالعالم.
ما ينقص هو نظام ثقافي عربي يدعم الترجمة، ويخلق مؤسسات نقدية مستقلة قادرة على إيصال الأدب العربي بلغته الأصلية إلى فضاءات الاعتراف العالمية.
ليس المطلوب أن “نتوسل” نوبل، بل أن نبني منظومة عربية للجوائز والاعتراف، تُقدّر الجمال قبل الجغرافيا.
خاتمة: العربية تستحق نوبل
على مدى قرنٍ وربع من الزمان، لم يُتوج بالعربية إلا نجيب محفوظ، لكنه حمل معه رمزية الأمة كلها.
إن الأدب العربي اليوم لا ينتظر نوبل ليكتمل، لكنه يستحق أن يُسمع ويُقرأ في كل لغات العالم، لأن في العربية من الجمال والعمق ما يجعلها جديرة بكل الجوائز.
ولعلّ التتويج القادم، إن تحقق، لن يكون تكريمًا لكاتب واحد، بل اعترافًا بلغتنا نفسها بوصفها لغة الإنسان والجمال.