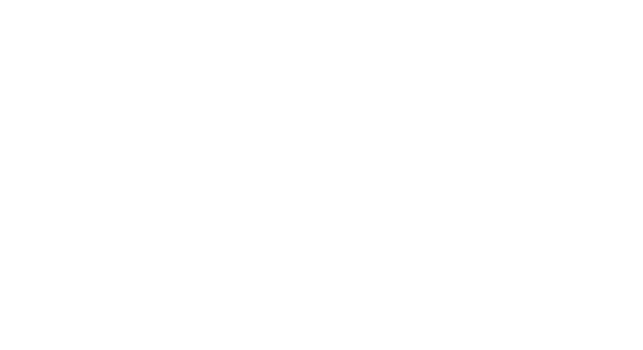جدول المحتويات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
وبعد فإن الاعتقاد الصحيح في الصالحين سبب من أسباب السعادة، بما يستلزمه من محبتهم والولاء لهم والائتساء بهم، وذلك مقتض لمعيتهم والإلحاق بهم في الآخرة، وقد يغلو فيه بعض الناس فيعُدّونه كافيا لنيل السعادة الأخروية، ويتحفظ عليه آخرون، إذ يرونه الطريق السابل إلى الشرك، وأوسع أبواب المروق من الدين، واختلاف تلك الآراء وتباينها تابع لاختلاف المنطلق حينا والتصور حينا آخر.
وبين لغط ذينك الموقفين المطلقين الصاخبين موقفي الغلو فيهم والجفاء عنهم يضيع غالبا صوت الموقف الوسط الذي يعترف لبعض الناس بخصوصيتهم الروحية البارزة، من دون أن يخرجهم بها عن الإطار البشري الذي يتميز به المخلوق عن الخالق، والعبد عن الرب. والحديث عن هذا المفهوم يقتضي تحديد مصطلحه، وتبيين مستوياته إن كانت، ثم الوقوف مع جهاته المتعددة التي من قِبَلها يعلق بالنفس وينفذ إلى القلب.
تحديد مصطلحي:
ولا بد أن نحدد مصطلح الاعتقاد الذي نروم دراسته، فهو يشمل عدة مستويات، تبدأ بالمحبة وتنتهي باعتقاد التأثير الذاتي.
أما المحبة فلا نقف معها لأن كل معتقَد في هذا الباب محبوب، يستوي في ذلك الغالي والجافي، إذ هي ميل فطري لا يستطيع المرء له دفعا متى ما توفرت دواعيه، فكل من بدت عليه سِيما الخير وظهرت عليه علامات الصلاح استوجب محبة الناس، ولا حرج في أن يخطئ عامة الناس في بعض الآحاد اعتقادا أو انتقادا، إذا هم انطلقوا من مبلغهم من العلم، وهم بعدُ في خفارة صدقهم.
إنما الشأن في اعتقاد التأثير استقلالا، حيث يجنح الغالي إلى أن من يعتقد فيه الصلاح بإمكانه أن يفعل ما يريد لمن يريد، كيفما يريد، واعتقاد ذلك في إنسان ما مهما بلغ في الصلاح والاستقامة هو من الشرك الأعظم الذي لا يغفره الله عز وجل.
ولا بد أن نخرج من هذا القسم من يعتقد أن تأثير معتقَده محكوم بإرادة الله النافذة ومشيئته المطلقة، بيد أنه يراه مستظلا بالحديث القدسي {فَإِذا أحببته كنت سَمعه الَّذِي يسمع بِهِ، وبصره الَّذِي يبصر بِهِ، وَيَده الَّتِي يبطش بهَا، ورجله الَّتِي يمشي بهَا، وَلَئِن سَأَلَني لأعطينه، وَلَئِن استعاذني لأعيذنه}. «صحيح البخاري» (8/ 105ط السلطانية).
والمقصود من يعتقد ذلك من قلبه، لا من يستدل به في ثاني حال، وبين الأمرين فرق، وأي فرق.
وعلى الطرف المقابل يقف الجافي على حدود شعور قلبي يتأثم حياله أن يترجمه تعبير لساني أو سلوك جارحي، فيمتنع من أبرز خصائص الاعتقاد، وهو التبرك باعتباره شركا محضا.
ولا بد أن نخرج من هذا القسم أيضا من يمتنع من التبرك سدا للذريعة أمام مخالفات سلوكية وعقدية شاهدها وخبرها، لا أنه يعتقد أن مجرد التبرك يعدّ شركا في حد ذاته، وبين الأمرين كذلك فرق.
ومن ذلك ما ذكره العلامة أبو الحسن اليوسي في محاضراته، تعليقا على حضوره لبعض الزيارات، حيث قال: “لم أوافقهم في فعل كثير مما يفعلون من ذلك مخافة أن يتخذني العوام حجة فيتغالون في ذلك، ومع ذلك لم أخل نفسي من التبرك بأمور قريبة لا بأس فيها”. «المحاضرات في اللغة والأدب» (ص: 23).
وفي الحق أن التبرك يقتضيه السَّواء النفسي متى توفرت شروطه، وتدل على جوازه الآثار الواردة عن السلف، ولو لم يكن كذلك لما تواتر عن كثير من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عروجه إلى الرفيق الأعلى، دون أن يسأل أي أحد منهم عن حكم ما يفعله أو يعترضه معترض، هذا وهم أبر الناس قلوبا وأحسنهم فطَرا وأزكاهم نفوسا.
والاستشهاد بعدم تبرك الصحابة بالخلفاء الراشدين على عدم جواز التبرك مع الجهل بدافعهم في ذلك مردود بأمرين، أحدهما أنه قد تقرر فِي الأُصول الْعِلْمِيَّةِ: أَنَّ كُلَّ مَزِيَّةٍ أَعطيَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فإِن لأُمته أنموذجاً منها، ما لم يدلَّ دليل على الاختصاص، «الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني» (2/ 306).
ولم يثبت ذلك الدليل، ولم يذكر أحد من الأئمة الذين كتبوا في خصائصه أن التبرك منها.
وثانيهما أن الفعل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وكل هذا بناء على القاعدة الأصولية القائلة إن التركَ فعل.
ضف إلى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم وإن غاب عنهم شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن آثاره الشريفة لم تزل بين أيديهم، فكانوا يتبركون برمانة منبره التي كان يضع عليها يده الشريفة، وبقدحه ونعله وشعره، وغير ذلك من آثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولعلهم رأوا أن تلك الآثار لا يعدلها شيء، وإن كان ما كان.
وأما عدم استفاضة التبرك في العصور اللاحقة للعصر الأول فإنه ـ على التسليم به ـ يدل على أنه ليس مطلوبا بالندب أو الوجوب، ولكنه لا يدل على عدم جوازه، سيما مع العلم أن عددا من أئمة العلم والدين فعلوه، وحسبك بالشافعي وأحمد رضي الله عنهما مثالا.
والحق أن أهل الجفاء نظروا إلى حال أهل الغلوّ أكثر من نظرهم إلى نصوص الباب وأصوله، فكان موقفهم أقرب إلى ردة فعل من كونه فعلا مؤسسا مبنيا على أصول وقواعد، وتلك طبيعة العمل البشري ولو كان هدفه الإصلاح فإنه لا بد أن يتأثر بالبيئة التي نبت فيها مسايرة لها أو مناقضة، ومن هنا كانت الحاجة أبدا إلى تجديد أمر هذا الدين، ليُنفى عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
جهات الاعتقاد:
ثم إنه لا بد من بيان جهات الاعتقاد، فإن المنتسبين إلى الاعتقاد في الصالحين كثُرٌ، ولكن الذين يعتقدون فيهم الاعتقاد الصحيح الذي ينتظمه الحب في الله قليل، ومن تأمل أحوال المعتقدين سوف يلحظ أن منهم:
أ ـ من يعتقد في الصالحين لما جرى على أيديهم من الخوارق والكرامات، واقفا مع الجانب العجائبي في التصرف، قاطعا للنظر عن النسبة التي بين العبد وربه، فهو بحسب ما شاهده ووقف عليه أو سمع عامة الناس يتحدثون عنه يكون اعتقاده وولاؤه، وعامة الناس مهما بلغوا من أَفَنِ الرأي وضعف المُنّة مجبولون على الإعجاب بمن يتميز عنهم في أعمالهم الاعتيادية.
ولا يعني ذلك أن الكرامات ليست من أمارات الصلاح، فهي شعبة من المعجزات، ولكنها تحتاج إلى بصيرة في الدين وعلم بالشرع تتميز به عما قد يشتبه بها،
وليس لأغلب الناس من ذلك ما يميزون به ما يكون صاحبه صحيح الحال صادق التوجه، فيكون ما ظهر على يديه كرامة، وما يكون صاحبه مدعيا كذابا فيكون ما ظهر على يديه مكرا واستدراجا.
والغالب على أهل هذا الاعتقاد الذي يغفل استحضار النسبة التي بين المعتقد فيه وربه الخوفُ من أن يصيبهم مكروه من جهة أولئك “الصالحين” أو من يمت له بسبب أو نسب، فإن العامة لما جهلوا صفات الله عز وجل من رحمة وعدل وتفرُّدٍ بالتقدير والتدبير وشاهدوا ما أجرى على أيدي أولئك القوم أو تنوقل إليهم ظنوه أمرا ذاتيا لهم، ومثل هذا الاعتقاد سوف ينتقل بصاحبه من الاعتقاد في الصالحين إلى الاعتقاد في أبنائهم وإن سَفُلوا، ذلك أن ضعف بصيرته وخوفه على نفسه وأهله يمنعانه من التفكير والمقارنة فضلا عن التمييز بين حق السلف وباطل الخلْف.
ب ـ من يعتقد في الصالحين لكونه ينتهي إليهم نسبه أو تتلمذه وطلبه، والغالب على صاحب هذا الاعتقاد هو رجاء المنفعة وتحقق المصلحة الدنيوية، بما يناله من تقدير وحظوة بحكم انتمائه الطيني أو الروحي إلى هذه الطريقة أو تلك، وقد يكون لصاحب هذا الاعتقاد علم شرعي يدرك به خطأ الطريق وانحرافه الذي يراه ويعايشه من الداخل، سواء كان ذلك الانحراف قديما أو مما استحدثته الأجيال اللاحقة، ولكنه بحكم ما حصل له أو يرجوه من رئاسة وفتوح احتاج إلى أن يقيم جاه شيوخه وآبائه إبقاء على حظه من ذلك.
والقاسم المشترك بين هذين الصنفين هو عدم القدرة على استماع أي نقد موجه إلى من يعتقدونهم، سواء كانوا مشايخ أو أجدادا، فضلا عن النظر إليهم بعين الحق ، ووزنهم بميزان الشرع الذي تنضح نصوصه بأن أهم خاصة لازمة للصلاح هي الاستقامة، وعلامتها الفارقة صحة المفاهيم الفكرية وتجريد القصد في الـأحوال القلبية، والاتباع في الأعمال السلوكية، وأن الجانب الديني لا يورث، بل يحتاج جهدا فرديا، يغالب فيه المرء نفسه، ويقهر هواه، ينطلق من قوله تعالى: {أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ} [العنكبوت: 3] ويستظل بقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لسيدة نساء العالمين: «.. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا» «صحيح البخاري» (4/ 7).
إلا أن أهل الموقف الأول لا يستطيعون ذلك خوفا على أنفسهم وأهليهم من أن تعتريهم بعض الآلهة التي يتخيلونها تنفعل لأغراض أولئك القوم بسوء، وأهل الموقف الثاني لا يستطيعونه حفاظا على حظوظهم وأغراضهم، لأن إبطاله يعود عليها ـ فيما يرون ـ بالإبطال.
وكل تلك الاعتقادات ليست من الاعتقاد الشرعي الصحيح في شيء، فإن الاعتقاد الصحيح إنما يكون لملاحظة أن بين المعتقَد فيه وبين ربه نسبة خاصة، تأنس إلى صاحبها النفس الزكية، ويهفو إليه القلب المؤمن، وقد يكون صاحب تلك النسبة خلَقَ الثياب مدفوعا بالأبواب، يقوم على نفسه وأهله من حرفة بسيطة، ويدع الناس من شره، كما قد يكون عظيم المنزلة مورود المنزل، قد وقف نفسه على القيام على عيال الله يبذل لهم من جاهه وماله، وقد يكون مجاهدا يطلب الموت مظانه في الثغور، كما قد يكون سياسيا بارعا ينازل مختلف أصحاب الاتجاهات والمذاهب من صناع القرار وموجهي الرأي، ليقر حكما دينيا أو يثبت مبدأ خلقيا، وقد يكون شيخا منعزلا في زاويته يعلم الناس الخير، ويرشدهم إلى البر، كما قد يكون صحفيا جالسا على منصته يوجه كاميراه إلى مواطن الخلل وأماكن النقص التي يعاني منها وطنه أو أمته، وقد يكون من غير أولئك، والخيط الناظم لكل ذلك هو معنى من الصلة بالله يسري في تلك الأعمال على اختلافها وتنوعها، يترجم عن حال إيماني قلبي متمكن، يدركه الوهم الصادق، بل تكاد تراه العين وتلمسه اليد.
فمن اعتقد من هذه الجهة في الصالحين المخلصين للإسلام المتمثلين لحقيقته، سواء كانت أعمالهم قاصرة أو متعدية، فردية أو جماعية، ظهرت على أيديهم بعض الكرامات أم لم تظهر كان ذلك الاعتقاد زيادة في إيمانه، وسببا في معيته لهم ولحوقه بهم، وإن قصر به عمله وقعدت به همته، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» «صحيح البخاري» (8/ 39) وما فرح الصحابة رضوان الله عليهم بشيء بعد الإسلام كفرحهم بهذا الحديث.
ومن اعتقد فيهم لغير ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه.