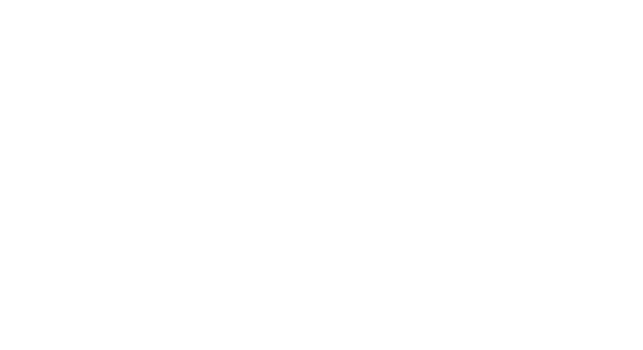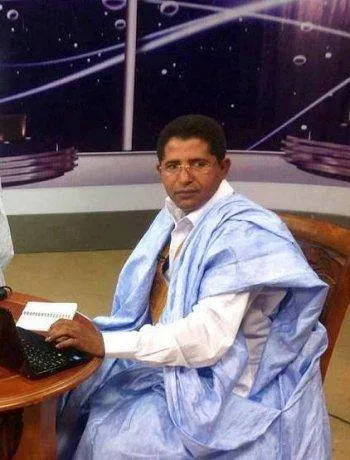جدول المحتويات
وأشار ولد سيدي عبد الله -خلال ندوة نظمها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية (مبدأ) مساء الأربعاء (29 – 7 – 2015) بنواكشوط، لنقاش كتاب "المفاضلات في الأدب الأندلسي .. الذهنية والنسق" لمؤلفه الباحث الموريتاني أدي ولد آدب – إن مصطلح "المفاضلات" مصطلح مخادع .. والدليل انه أغرى الدكتور "ادي" بالغوص في الأنماط المنضوية تحته في أدب الأندلس لدرجة تأكد معها أن الحياة الاندلسية كانت قائمة على التفاضل والتفاخر في كل شيء، فكل الثنائيات الحياتية أخضعها القوم للتفاضل فنتجت عن ذلك مدونة شعرية ونثرية هائلة، هي في النهاية ما يمكن ان نطلق عليه (الادب الاندلسي بكامله).
وفيما يلي نص المقاربة:
"التجاوز" كنسق يحكم الذهنية الأندلسية
مقاربة لكتاب ( المفاضلات في الادب الاندلسي) للدكتور ادي ولد آدب
=====================
د . الشيخ ولد سيدي عبد الله
دعوني بداية أتساءل : هل يجوز التواضع في لغة العتبات والعناوين؟
هل الخشية من الغرور تبرر اختزال الاعمال الكبرى في عناوين جزئية؟
ان المتأمل في العتبة الاولى لهذا العمل الذي بين أيدينا لابد أن يستغرب كيف أن الدكتور ادي لم يضع للكتاب عنوانا أكثر شمولية هو (الادب الاندلسي – الذهنية والانساق) ذلك ان ما قام به هو اعادة لقراءة هذا الادب بكامله وعملية تأسيس لبنية الثقافة الاندلسية من خلال نسق كان كامنا في الوجدان الأندلسي والمغربي على السواء وهو نسق الابداع والاتباع أي نسق التجاوز.
هل الادب الاندلسي مجرد نسخة مموهة من الادب المشرقي؟ وهل العقد الفريد مجرد بضاعة مشرقية في قالب اندلسي؟.
ان نسق التجاوز هو نسق اخترق الزمن العربي في الاندلس وظل متحكما في الحركة الثقافية والفنية هناك … وتكاد الابداعات الاندلسية تشكل نمطا من السمو على نظرية الاتباع تلك .
وبحكم معرفتي الشخصية بالمؤلف أعرف انه لا يعاني من عقدة (المركز والأطراف) واعرف انه تجاوزها عمليا ونفسيا منذ كتابه الاول (الايقاع في المقامات اللزومية عند السرقسطي) ..
ورغم ذلك ما الذي يمكن أن يبين عنه مصطلح المفاضلات دون غيره من المصطلحات؟ .. انه مصطلح مخادع .. والدليل انه أغرى الدكتور ادي بالغوص في الانماط المنضوية تحته في ادب الاندلس لدرجة تأكد معها ان الحياة الاندلسية كانت قائمة على التفاضل والتفاخر في كل شيء … كل الثنائيات الحياتية أخضعها القوم للتفاضل فنتجت عن ذلك مدونة شعرية ونثرية هائلة، هي في النهاية ما يمكن ان نطلق عليه (الادب الاندلسي بكامله) ..
دعوني ابدأ بمصادرة تقول :
إن ردة فعل الهامش والمركز وشعور الاندلسيين بها شكلت حافزا لاحقا للدكتور ادي لتناول هذا الموضوع الذي تجاوزه دارسو الادب المشارقة ضمن تجاوزهم للظاهرة الابداعية الاندلسية ككل.
ومن هنا جاءت فرادة هذا الكتاب فبدا مستكشفا و مجددا لقراءة مقولة الصاحب بن عباد عن العقد الفريد (بضاعتنا ردت إلينا) … تلك المقولة التي خلقت النسق وهيأت الذهنية له.
ياقوتة ابن حزم :
تحت هذه الجملة يقدم الدكتور ادي في الصفحات الاولى من سفره هذا إطارا مرجعيا لكل ما سينضوي تحت العنوان العام للعمل .. هذه الياقوتة التي آثرها ابن حزم على غيرها من المجوهرات هي الاندلس نفسها .. الاندلس التي لا تشبه غيرها ولا تريد ان تشبه غيرها ..
هي البلاد ذات الخصوصية الفريدة في المكان والانسان والحيوان، في اللغة والابداع .
والطريف هنا ان الاندلسيين في مفاضلاتهم الواعية وغير الواعية، لم يقبلوا الاستكانة لبعض المسلمات البسيطة في النقد الادبي عند المشرق مثل (طبقات الشعراء) فإذا كان نقاد الادب العربي سلموا بمقولة الجاحظ في البيان والتبيين التي تقول :
"والشعراء عندهم أربع طبقات، فأولهم : الفحل الخنذيذ، والخنذيذ هو التام، قال الأصمعي : قال رؤبة : (الفحولة هم الرواة)، ودون الفحل الخنذيذ : الشاعر المفلق، ودون ذلك : الشاعر فقط، والرابع : الشعرور (…) وسمعت بعض العلماء يقول : طبقات الشعراء ثلاث : شاعر، وشويعر، وشعرور.."[1] .
فإن الاندلسيين تنكبوا ذاك الطريق ونظروا الى الشعراء من زاويتهم التي تجمع بين الجمال والأخلاق، ومثاله قول ابي بكر الشنتريني :
" اعلم ان الشعر وإن كانت فضائله كثيرة ومنافعه معروفة مشهورة فإن غوائلَه مخوفة ومناهلَه بالشر محفوفة، وذلك أن :
رديئه عورة فاضحة إن لم يُستَر
ومتوسطهُ فضيلة واضحة لا تُنكر
والجيد منه لا يُنال إلا باستغراق الاوقات واهمال المهمات من أجله" . ص 153
ولكن لا غرابة في أن يشكل هذا النسق الاندلسي والذي اسميناه (نسق التجاوز) نتيجة حتمية لسياق ثقافي تحكمه آليات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت أن تؤسس جنة كونية على الارض.
والحق أن ادي ولد ادب انتبه لهذه الخاصية، يقول : إن الاندلس المتقمصة روح المدينة الفاضلة، فاخرت الجنة العليا فكيف لا تفاخر ما سوى ذلك وتنازعه قصب السبق حتى ولو كانت بلاد المشرق التي هي أصلها ومرجعيتها الكبرى؟ فعلى الرغم ما كان يطبع المشرق من تعالي المركز على الاطراف المؤجج بخلفيات سياسية وحضارية كثيرة فإن العلاقة بالاندلس شهدت حركة مد وجزر من خلال تجاذبات أصل يرمز بطبعه الى الرسوخ وفرع ينزع بطبعه الى الشموخ"[2] .
ثم يضيف الدكتور ادي موضحا : " كان المشرق – في البدايات – يتحفظ على أي فضل للاندلس وينظر اليها نظرة لا تخلو من ازدراء وكانت الاندلس في البدايات لا تجد قبلة ولا قدوة افضل من المشرق راغبة في التماهي معه والاستقلال عنه في الوقت نفسه.
ومع مرور الزمن تبيّن أن استهانة المشرق بالاندلس ربما كانت إضافة الى الاسباب الاخرى راجعة الى غلالة من الجهل ظلت تحجب ذلك الافق البعيد المتمرد عن مرمى ابصار وبصائر المشارقة المتمركزين حول ذواتهم وما قصة أبي علي القالي منا ببعيدة فقد كان في طريقه الى الاندلس – على الرغم من جاذبيتها التي استقطبته من بغداد – مزودا بشحنة كبيرة من عقلية (المركز والاطراف) جعلته يقيس فضل البلاد وعلمها بعلاقتها المكانية مع المشرق قربا او بعدا، فيجد أهلها (درجات في الغباوة وقلة الفهم بحسب تفاوتهم بمواضعهم منها بالقرب والبعد، كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم مُحَاصَّة ومقايسة . قال ابوعلي القالي : فقلت : ان نقص اهل الاندلس عن مقادير من رأيتُ في أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج الى ترجمان في هذه الاوطان"[3] .
ان هذا النسق التجاوزي والذي يضع في الحسبان سياق جدلية المركز والمحيط هي التي تحكم النماذج التي رصدها الكتاب من المفاضلات .
وكما قلت ليس هدف الدكتور ادي ولد آدب ان يفتح جرحا غائرا ولا أن يعيد فتح نقاش ثقافي متجاوز ولم يعد كما كان بفعل تغير المراكز والهوامش وتبادل الادوار.. ورغم ان هدفه ليس ذلك الا انه لا يستطيع ان يغض الطرف عن الذهنية التي حكمت المفاضلات الاندلسية وهي ذهنية محكومة بنسق التجاوز حتى في الفضاء الاندلسي نفسه وهو ما عبر عنه الباحث في (مفاضلات المكان) ..
تلك رؤية وذاك فهم .
مسألة اخرى تثير الناظر في هذا العمل الجبار وهي ان الدكتور ادي ولد آدبة رغم تمكنه من المصطلح النقدي البنيوي وما بعد البنيوي ورغم اطلاعه على اسهامات النقد الثقافي لم ينجر كما وقع للكثيرين نحو التجريب والابتسار وفرض مناهج ومصطلحات على أدب لا يقبل ذلك .
قد يقف قارئ تفاعلي – نموذجي أمام مصطلح (الانساق) الذي ورد في عنوان الكتاب متسائلا هل الكتاب يدخل ضمن المساهمات العربية في (النقد الثقافي) وسيزداد حيرة عندما لا يجد في الفهرس أي مصطلح ينتمي لهذا النقد، بل سيتفاجأ بمصطلح بارتي معروف وهو (الكتابة في الدرجة صفر) والذي تناوله الدكتور ادي استعاريا في الفصل الرابع من الكتاب .
ومعروف ان البارطية سبقت النقد الثقافي بكثير وان كانت منحته بعض تأملاتها … ان هذا التصرف في المصطلح هو احد مميزات هذا العمل ذلك ان تحاشي المفاهيم خوفا من السقوط في شرك المناهج هو ظلم للنص والقارئ … وهو ما وعاه الدكتور ادي واستخدم مصطلح (المفاضلة) بدلا من مصطلحات نصية مشابهة (التناص والنص الغائب وعبور الكتابة) وغيرها .
وحتى لا أطيل اتجاوز الى ملاحظة اثارتني هي الاخرى وهي انني كنت اود من صديقي الدكتور ادي في حديثه عن التواصل الثقافي بين الاندلس وافريقيا ان يتعرض لنموذج أكثر نصاعة من نماذج كثيرة ورد بعضها في الكتاب وهذا النموذج هو (ابو اسحاق الساحلي) المعروف ب (الطويجن) والذي وصل حتى مشارف ولاتة وتشيشت ..
ودعوني اقدم لكم نبذة مختصرة عن هذا الرجل وعن علاقته ببلاد شنقيط، ذلك انني اعتبرته سابقا هو اول من أدخل لامية العجم ومقامات الحريري لهذه البلاد (بلاد التكرور) :
هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الساحلي، وقد " ولد بغرناطة ونشأ فيها وقرأ على أعلامها، ولم يذكر الذين ترجموا له تاريخ ولادته، ونقدر أنها كانت في أول الثلث الأخير من القرن السابع الهجري"[4] .
وبسبب نشأته المترفة في بيت والده، الذي كان شيخ العطارين بغرناطة، والذي عرف بالصلاح والأمانة، أصبح الساحلي أحد أهم الكتاب والأدباء في عصره، لكن ظروفا مختلفة أدت به إلى الهجرة عن غرناطة، من بينها ما سماه ابن الخطيب : "كساد سوقه وضياع حقوقه "[5] .
وكانت رحلته إلى مصر، واتصل هناك ببني الأثير، وهم كتَبة الإنشاء في ديوان الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم زار دمشق والعراق واليمن.
أما حكايته مع بلاد التكرور والسودان، ولامية العجم، فقد روتها كتب التراجم كما يلي :
" شاء الله أن يحج الساحلي، في العام الذي حج فيه سلطان مالي، أما العام فهو 724هـ/1325م وأما السلطان فهو منسا موسى، الذي ذهب عام حجه مثلا شرودا، وبقي حدثا بارزا يؤرخ به، فقد صحبه خلق عظيم يعدون بالآلاف، وكان معه مائة حمل من الذهب فغمر الناس – حيثما حل- بعطاياه، وبهرهم بخصاله الحميدة ومزاياه، وكان الذهب الذي أنفقه في مصر والحجاز، سببا في نزول قيمته وهبوط سعره .
وخلال موسم الحج لقيه الساحلي، فأصبح من أصحابه .."[6] .
وتتوقف هنا أغلب مصادر التاريخ، عن تفاصيل أول لقاء بين الرجلين، إلا أن أدب الساحلي الجم، وتبحره في اللغة والشعر، وجمال خطه، وحسن مسامرته، بفعل الدربة على مجالسة ذوى الشأن العالي، كلها أسباب تجعل حصول الألفة بين الرجلين، أمرا غير مستبعد .
وهو ما حدث بالفعل، فقد أضحى الساحلي جليسا دائما للملك منسا موسى، سواء في مكة أو المدينة المنورة، "وخلال هذه الفترة أنجز عملا أدبيا أعجب به السلطان، ولعله كان باقتراح منه، وهذا العمل هو تعجيز صدور القصيدة الطغرائية، وتصدير أعجازها، وقد وصل إلينا هذا العمل رواية عن منديل بن أجروم (…) كما قام بإنشاء روضة أدبية، تحتوي على نظم ونثر وتصف الحال في الزورة النبوية "[7] .
ونحن نعتقد أن هذه الروضة، هي إحدى أهم مظان نشأة أدب الرحلة، في الثقافة التكرورية لاحقا، إلا أن بن شريفة يراها تلك المعارضة، التي قام بها الساحلي لقصيدة (البردة) مع أن المصادر التي أوردت ميميته، لم تشر إلى مناسبتها وموضوعها[8] .
وهكذا جاء تعجيز وتصدير الساحلي، للامية العجم على النحو التالي :
أَصَالَةُ الرَّأْيِ صَانَتْنِي عَنِ الخَطَلِ
وَلَذَّةُ الجُودِ أَبْقَتْنِي عَلَى سَغَبٍ
وَشِيمَةُ الحِلْمِ صَدَّتْنِي عن الزَّلَلِ
وَحِلْيَةُ الفَضْلِ زَانَتْنِي لَدَى العَطَلِ[9]
بينما جاءت معارضته لميمية البوصيري هكذا :
تَأَلَّقَ البرقُ مُجتازًا عَلى إِضَمِ
وَصافحَ السَّفْحَ من أكْنافِ كَاظمةٍ
فَبِتُّ أَعْشُو لِوَقْدٍ منهُ مُضْطَرِمِ
وَسالَمَ الدَّوْحَ من عَلْيَاءِ ذِي سَلَمِ[10]
هكذا إذن وصل الساحلي إلى مالي، وعاش مكرما مع السلطان منسا موسى، وكان رائد حركة شعرية وثقافية كبيرة، وقد اعتبر أغلب المؤرخين، أن وجود الساحلي بمملكة مالي، ساهم في تواجد جالية عربية كبيرة هناك، خصوصا وأن السلطان كان – كما يقول ابن بطوطة- يحب البيضان ويحسن إليهم، ولهذا انتشرت أحياء البيضان، في تمبكتو وكوكو الماليتين .
ومع ازدياد هذه الجالية، كان من اللازم أن يتم التزاوج بين العرقين، مما جعل الساحلي يخلف "ذرية من نسائه وإمائه الماليات، ذكرهم ابن الخطيب مازحا، وشبههم بالخنافسة، وتحدث عنهم ابن خلدون في تاريخه جادا، فقال إنهم كانوا وقت تدوين تاريخه، ما يزالون يعيشون على ما كان لوالدهم من جاه، ولكنهم انتقلوا من تمبكتو إلى ولاتة "[11] .
ويؤكد وجود جالية أندلسية الأصل، في بلاد التكرور أن البرتلي، ترجم لمن دعاه علي بن أحمد بن محمد عبد الله الأنصاري الأندلسي ثم المصري، وأنه عالم بالنحو، رحل من الأندلس إلى بلاد التكرور، وأقرأ أهلها القرآن، وقد ذكره السيوطي في طبقات النحو[12] .
ويضيف بن شريفة معلومة أخرى مفادها: أنه يوجد "اليوم في تمبكتو أسرة علمية، هي أسرة الأنصاريين، وهي ترفع نسبها إلى بني نصر ملوك غرناطة، والأقرب أن تكون منسوبة إلى الساحلي الأنصاري "[13] .
أما مولاي أحمد بابير الأرواني، فيشير إلى قدوم الكثيرين من شتى القبائل والأمصار، إلى مدينة تمبكتو، واختيارها موطن ثواء دائم، خصوصا أولئك القادمين من مصر وفاس ومراكش وتافلالت وغدامس.. إلخ، وقد وصل الأمر حدّاً جعل كل مجموعة من أولئك، تختص بحي يأخذ إسمها، حيث كان هناك حي الغدامسة، وحي المراكشية، وغيرهما[14] .
ويهمنا من هذا كله، أن الساحلي عاش في ولاتة فترة من الزمن، وقد قال المقري في نفح الطيب : إنه هو من بنى جامع تمبكتو الكبير، على الطراز الأندلسي، وأنّه توفّي بتنبكتو سنة نيّف وأربعين وسبعمائة.
أما الرواية الشفوية، التي تتردد اليوم في ولاتة، فتحكي عن شاعر ينسب إليه الطراز الهندسي، الموجود في هذه المدينة، وما هو إلا الساحلي، الذي استقر أولاده فيها، ولعلهم كانوا من النواة الأولى للحركة العلمية، التي ظهرت فيها، في عهد مملكة السانغاي وما تلاها[15] .
لقد كان الساحلي شاعرا مفلقا، ولعله من أوائل الشعراء في المنطقة، وتحتفظ المصادر اليوم باثنتي عشرة قصيدة له، وبثلاث مقطوعات، وإذا أضيف إليها تصديره وتعجيزه للامية العجم، يكون مجمل شعره المتاح، يزيد على الأربعمائة بيت .
وقد دار شعره، بين أغراض المدح والوصف والغزل، ومن رقيق غزله قوله[16] :
زَارَتْ وَفِي كُلِّ حَيًّ لَحْظُ مُحْتَرِسِ
يَشْكُو لَهَا الْجِيدُ مَا باِلحُلْي مِنْ هَذَرٍ
فِي لَحْظِهَا سِحْرُ فِرْعَوْنٍ وَرِقَّتُهَا
وَحَوْلَ كُلَّ كِنَاسٍ كَفُّ مُفْتَرِسِ
وَيَشْتَكِي الزَّنْدُ مَا بِالْقَلْبِ مِن خَرَسِ
آَيَاتُ مُوسى وَقَلْبِي مَوْضِعُ اْلقَبَسِ
اعود واقول انني كنت احبذ ان يكون الساحلي هذا واحد من النماذج التي تحدث عنها الدكتور ادي في مبحث التواصل بين افريقيا والاندلس، خصوصا وان في شعره ما يشكل مفاضلة مع نصوص مغربية ومشرقية عديدة .
وختاما يبقى هذا الكتاب رائد وفريدا في مجاله باعتباره اول عمل يتمحض لموضوعه فصاحبه أنشأ فرعا بحثيا جديدا لم ينتبه اليه من سبقوه .
واعتقد ان خاصية الفرادة هذه هي السر في فوزه بالنشر من طرف هيئة بحثية واكاديمية عالمية مثل (المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات) الذي يرأسه الاكاديمي الكبير عزمي بشارة.
[1] – البيان والتبيين – ج 2 – ص 9 – 10
[2] – المفاضلات في الادب الاندلسي 335
[3][3][3] – نفسه والصفحة نفسها
[4] -محمد بن شريفة – من اعلام التواصل – ص 82
[5] – نفسه – ص 86
[6] – نفسه – ص 91
[7] – نفسه – ص 92
[8] – نفسه – ص 93
[9] – نفسه – ص 92
[10] – نفسه – ص 93
[11] – نفسه – ص 103
[12] – فتح الشكور – ص 196
[13] – محمد بن شريفة – من أعلام التواصل – ص 107
[14] – مولاي أحمد بابير الأرواني: "السعادة الأبدية في التعريف بعلماء تمبكتو البهية"، دراسة وتحقيق الهادي الدالي – جمعية الدعوة الإسلامية – طرابلس 2001 – ص 51
[15] – من أعلام التواصل – ص 111
[16] – نفسه – ص108