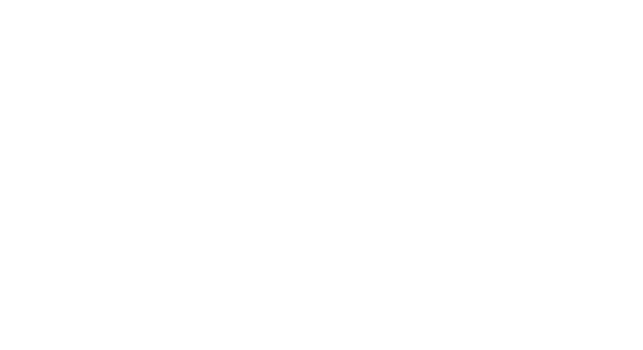جدول المحتويات
قراءة نقدية في منهجية التظلم ومسؤولية الدفاع المهني في شكاية ضد المدير العام للأمن الوطني
في زمن يتطلع فيه الرأي العام إلى أن يكون رجال القانون قدوة في ترسيخ ثقافة الإنصاف وتعزيز الثقة في المؤسسات، تبرز أحيانًا ممارسات تثير التساؤل لا عن مضمونها بالضرورة، بل عن أسلوبها، وتوقيتها، وما توحي به من مقاصد ضمنية. من ذلك ما طُرح مؤخرًا من شكاية منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي يخص إعادة ترتيب أحد موظفي سلك الشرطة.
وقد وُجهت الشكاية مباشرة ضد المدير العام للأمن الوطني، وهو ما يثير التساؤل حول مدى دقة توجيه المسؤولية، والجدوى القانونية لهذه الخطوة، في ظل طبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها هذا المنصب الحساس.
قد يُفهم من ظاهر هذه الخطوة أنها دفاع عن تنفيذ حكم قضائي وطلب لإنصاف متضرر. غير أن التوقف عند الكيفية التي قُدّمت بها، وتجاوزها للمساطر الإدارية المتعارف عليها، وطرحها في قالب إعلامي فجائي، يفتح الباب لتساؤلات مهنية مشروعة لا يمكن التغاضي عنها.
منهجية التظلم: هل تم استنفاد المساطر المؤسسية؟
حين يُطلب تنفيذ قرار صادر عن القضاء، فإن الطريق الطبيعي يمر – كما هو معلوم لدى أهل المهنة – عبر الوكالة القضائية للدولة، بصفتها الممثل القانوني للإدارة والمخول بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أو لصالح موظفيها. لذلك يُطرح سؤال مشروع: لماذا لم يُسلك هذا المسار أولًا؟ وهل تم تجاوزه عن قصد، رغم كونه المسار الإجرائي الأصلح والأكثر فاعلية؟
حول تنفيذ الأحكام: التوقيت والسياق لا يُغفلان
إن مسألة تنفيذ الأحكام الإدارية – كما هو معلوم في العمل المؤسسي – قد تتداخل فيها اعتبارات متعددة، تنظيمية وإجرائية، قد تؤثر على توقيت التنفيذ أو طريقة إنفاذه. وليس كل تأخر في التنفيذ يُفهم تلقائيًا على أنه امتناع، كما أن التقييم الموضوعي لأي تأخر يظل رهينًا بظروف الملف وطبيعة القرار والمسؤوليات المرتبطة به. ومن هنا فإن استخلاص نية المخالفة أو توجيه اتهام مباشر دون استيفاء المعطيات القانونية والمؤسسية، قد يكون استباقًا لا يخدم لا الإنصاف ولا النظام.
موقفنا من تنفيذ الأحكام القضائية
نود التأكيد على أننا لا نعارض تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، بل نؤمن بأن احترام القضاء واجب وركيزة أساسية لأي نظام قانوني سليم. إن تنفيذ الأحكام يعزز ثقة المجتمع في العدالة ويكرّس حكم القانون. ومع ذلك، فإن الدفاع عن تنفيذ هذه الأحكام لا يعني التغاضي عن ضرورة احترام المؤسسات والأشخاص وعدم المساس بهما أو التشهير بهما بوسائل غير مهنية. لذا، فإن سعينا هو لتأكيد التنفيذ وفق المساطر القانونية والإجرائية المتبعة، وبما يضمن حق المتضرر دون المساس بمكانة المؤسسات أو الأشخاص.
نشر الشكاية… تشهير أم استحقاق؟
المثير للقلق في هذا السياق ليس مضمون الشكاية فقط، بل نشرها العلني على وسائل التواصل الاجتماعي. فمثل هذه الممارسة تُخرج الشكوى من إطارها القانوني، وتُلقي بها في ساحة الجدل والتأويل، وتوحي بأن الغرض قد لا يكون فقط المطالبة بتنفيذ حكم، بل التشويش على مؤسسة أمنية وطنية محترمة، والمسؤول الأول فيها، في توقيت حساس.
إن نشر الشكاية لا يُعد دليلاً على عدالة المطلب بقدر ما قد يُفهم منه أنه محاولة للإضرار بسمعة شخص أو مؤسسة، وإقحام ملف قانوني في مهب أحاديث الرأي العام. وهنا تبرز الحاجة لتفكير أعمق: هل نريد من وسائل الإنصاف أن تُستخدم في سياق قانوني سليم؟ أم أن تتحول إلى أدوات ضغط تُفقدها مضمونها القضائي؟
النيابة العامة… الجهة المختصة الوحيدة
يبقى من المسلم به قانونًا أن الجهات المختصة وحدها، وفي مقدمتها النيابة العامة، هي المعنية قانونًا بتقدير ما إذا كانت الوقائع المرفوعة إليها تُشكل إخلالًا يستدعي المتابعة، أم أنها تندرج ضمن إشكالات الإدارة وتقديراتها الداخلية.
وفي هذا السياق، فإن إثبات الضرر بالنسبة للطرف الذي يدعيه يظل عنصرًا جوهريًا، ما لم تكن هناك موانع حقيقية أو ظرفية تجعل التنفيذ غير ممكن أو مؤجلًا لأسباب عملية أو تنظيمية، وهو أمر وارد في بعض أنواع القرارات الإدارية، لا سيما تلك التي تمس البناء الوظيفي أو الهيكلي للمؤسسة.
لكن تقدير وجود هذه الموانع أو عدمها، وتحديد ما إذا كان ثمة تقصير أو مجرد تأخير، أمر يعود إلى الجهات المعنية بحسب اختصاصها وصلاحيتها، وفي ضوء ما يتوفر لديها من معطيات واعتبارات عملية لا تُدرك دائمًا من خارج الإدارة.
السياق والمسؤولية المهنية
الشخصيات الوطنية السامية لا تُحاسب عبر الأثير، ولا تسلك مسلك الإعلام في تسيير الصراع أو حلّ الخلافات مع المسؤولين السامين، لما لذلك من تأثير سلبي على المؤسسة وسمعتها، ولخطورته على الذوق العام. فمثل هذه القضايا لا تُعالج عبر منصات التواصل، بل هناك طرق إدارية ومهنية أخرى تتيح معالجة الخلافات وحفظ هيبة المؤسسة.
وإذا كانت الغاية هي الدفاع عن موظف مظلوم، فذلك لا يتعارض مع واجب التحفظ، ولا يستدعي تحويل الملف إلى منصة للنيل من رموز مؤسسية.
الدفاع لا يُستغل خارج الأطر المهنية
إن الدفاع، بما يمثله من شرف ورسالة، لا ينبغي أن يُستغل خارج الأطر المهنية التي تُنظمه وتُؤطر مسؤوليته. فالمحاماة ليست أداة للضغط الإعلامي، ولا وسيلة لتصفية الحسابات أو التشهير بالخصوم، مهما كانت الظروف.
بل هي ممارسة قانونية رفيعة، تُحتكم فيها الوسائل إلى مقتضيات الأخلاق المهنية، ويتجلى فيها احترام المؤسسات، والحرص على المصلحة العامة، قبل الانتصار لأي موقف جزئي أو رد فعل شخصي.
ومن هنا، فإن إخراج الدفاع من مجاله المهني إلى فضاء الإثارة والمزايدة، يُضعف من قيمته، ويُربك رسالته، ويضر بصورة المهنة التي نحرص جميعًا على صون هيبتها.
خاتمة: من أجل ثقافة قانونية مسؤولة
لسنا هنا بصدد التشكيك في وجاهة أي مطلب مشروع، إن وُجد، ولا في دوافع الزملاء، ولكننا نُذكّر بأن الطريق القانوني لا يكتسب قوته من العاطفة، بل من حسن التقدير.
والغيرة على الحقوق لا تُبرَّر باستخدام وسائل قد تُهين رمزية المؤسسات بدل أن تنصف المتضرر، ولا تُخدم العدالة إن هي ارتبطت بمنهجية تهدف إلى الإثارة بدل التصحيح.
نحن في حاجة إلى ترسيخ ثقافة قانونية مسؤولة، تُعلي من شأن المؤسسات، وتحتكم إلى القانون، وتحترم آليات الإنصاف، بعيدًا عن المزايدات الإعلامية أو مسالك التصعيد غير المؤسسي.
فهيبة العدالة لا تُنال بالصوت العالي، بل بالمنهج القويم؛ ولا تُبنى على الانفعال، بل على النزاهة المهنية، ونُبل الوسيلة.