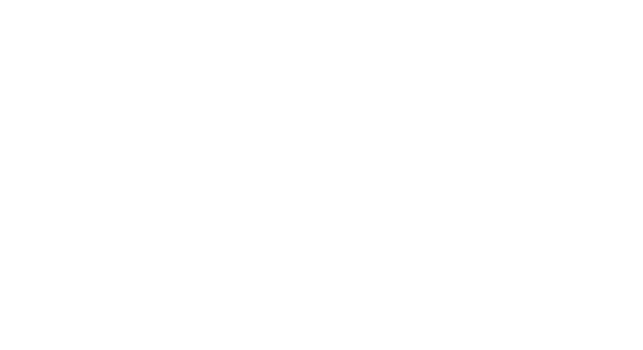جدول المحتويات
مقدمة
يجدر في مستهل هذه القراءة التوضيح بأن الهدف منها هو الإسهام في إثراء النقاش العمومي حول دور محكمة الحسابات، لا التقليل من الجهود المبذولة ولا التشكيك في كفاءة أعضائها.
ويندرج هذا التحليل في إطارٍ تقني صرف، يرمي إلى إبراز بعض الثغرات ذات الطابع المنهجي والمضموني التي شابت التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022 – 2023، بالنظر إلى النصوص المنظمة لعملها، ومبادئ تسيير المالية العامة، والتقييمات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA).
وقد كشفت آخر تقييمات PEFA عن استمرار بعض أوجه القصور على مستوى أداء محكمة الحسابات، سواء من حيث تعزيز القدرات المؤسسية، أو متابعة تنفيذ التوصيات، أو ممارسة رقابة الأداء، وهو ما يمثل مؤشرا مرجعيا لتقييم مدى اتساق ومردودية تقريرها العام السنوي.
غير أن تحليل هذا التقرير يُعد مهمة معقدة، ليس فقط بالنظر إلى مكانة الجهة التي أصدرته، باعتبارها المؤسسة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على المالية العامة، وما يفترض أن يتسم به عملها من صرامة منهجية ودقة فنية، انسجاما مع مسار إعداده الذي يمر عبر تشكيلتين من المحكمة هما لجنة التقارير والبرامج وغرفة المشورة، وإنما أيضا بسبب طبيعة التقرير ذاته، وما يطرحه من قضايا متشابكة تستوجب قراءة متعمقة وتحليلا متوازنا.
وعليه، فإن هذه المعالجة التحليلية للتقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات تقترح، في مرحلة أولى، وضع التقرير ضمن إطاره المؤسسي والقانوني (I)، تمهيدا للانتقال، في مرحلة ثانية، إلى دراسة منهجيته ومضمونه التحليلي (II).
I. الإطار المؤسسي والقانوني للتقرير:
1. إصلاحات هيكلية في المالية العامة:
يصدر التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات في سياق تحول عميق تشهده منظومة المالية العامة الوطنية، وهو مسار إصلاحي انطلق منذ إنجاز أول تقييم شامل وفق منهجية PEFA سنة 2008.
وقد أتاح هذا التقييم تشخيصا دقيقا لنقاط القوة ومواطن الضعف في المنظومة المالية العمومية، مما مهد الطريق نحو اعتماد أول مخطط توجيهي لإصلاح المالية العامة (SD-RFP 2012-2016).
وقد وضع هذا المخطط الأسس المؤسسية والفنية للإصلاح المالي، التي جرى لاحقا تعزيزها وتوسيع نطاقها من خلال المخططين التوجيهيين (SD-RFP 2021-2025) و(SD-RFP 2025-2030)، واللذين يندرجان في منطق الاستمرارية وتحقيق الأداء وتعزيز الشفافية الميزانونية، استنادا إلى تقييمات متخصصة، من بينهاPEFA آنف الذكر، وPIMA لتقييم إدارة الاستثمار العام، وTADAT لتقييم أداء الإدارة الضريبية، وDeMPA لتقييم إدارة الدين العام.
2. تحديث الإطار الميزانوي والمحاسبي:
في صميم هذه الديناميكية، يشكل القانون العضوي رقم: 2018 – 039 المتعلق بقوانين المالية (LOLF) حجر الزاوية في منظومة الحوكمة المالية الجديدة، إذ يهدف إلى مواءمة تسيير المال العام مع المعايير الدولية من خلال تحديث الأطر الميزانوية والمحاسبية والجبائية للدولة، وترسيخ منطق النتائج والمساءلة بدلا من منطق الوسائل، وذلك عبر إرساء برمجة ميزانوية متعددة السنوات تعتمد على وثيقة برمجة الميزانية متوسطة الأجل(DPBMT) التي تضم إطار الميزانية متوسط الأجل (CBMT) وإطار النفقات متوسط الأجل (CDMT-g).
كما أدخل هذا القانون إصلاحا محاسبيا جوهريا يقوم على اعتماد محاسبة عامة للدولة قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والالتزامات، وقد تُرجمت هذه الإصلاحات عمليا عبر مراجعة المخطط المحاسبي للدولة سنة 2022 وتحديث التبويب الميزانوي والمحاسبي (NBCE 2024)، بما يعزز الترابط بين المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة، ويمهد لإعداد الميزانية الافتتاحية للدولة وفق المعايير الحديثة للشفافية والمساءلة المالية.
وفي امتداد مباشر لأحكام القانون العضوي لقوانين المالية (LOLF)، جاءت إصلاحات المنشآت العمومية بموجب القانون رقم: 2025 – 002 لتُسهم في تطوير أساليب تسيير المؤسسات والشركات العمومية، وذلك من خلال:
– إنشاء تصنيف جديد يضع قواعد تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل فئة من المنشآت العمومية؛
– اعتماد المحاسبة التجارية بدلا من المحاسبة العمومية؛
– إلزامية تصديق الحسابات من طرف خبراء محاسبين أعضاء في السلك الوطني للخبراء المحاسبين؛
– إدماج أعضاء مستقلين ضمن جميع هيئات المداولة؛
– الملاءمة مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وتعزيز آليات الرقابة الداخلية.
أما على الصعيد الجبائي، فقد أحدث القانون رقم: 2019 – 018 المتعلق بالمدونة العامة للضرائب (CGI) إصلاحات مهمة على المنظومة الضريبية بهدف تعزيز الوضوح والامتثال، وتمثلت أبرز هذه التعديلات فيما يلي:
– تحديث نظام الضريبة المباشرة على الأرباح عبر إدخال الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على أرباح الأعمال للأشخاص الطبيعيين (IBAPP)؛
– تعميم إلزامية مسك محاسبة تجارية مع استثناء النظام الجزافي؛
– تعزيز المنظومة المتعلقة بالتفسير الإداري الجبائي (doctrine fiscale)؛
– وضع نماذج جديدة للحزم الجبائية التصريحية (liasses fiscales).
3. إعادة تحديد الدور المؤسسي لمحكمة الحسابات:
في هذا السياق العام، خضعت محكمة الحسابات لإعادة تنظيم بموجب القانون العضوي رقم: 2018 – 032، الذي وحد النصوص السابقة الصادرة سنة 1993 ووسع نطاق اختصاصاتها. فإلى جانب اختصاصاتها الثلاثة المتمثلة في مساعدة البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، والرقابة القضائية التي تبت فيها المحكمة في حسابات المحاسبين العموميين وتُعاقب أخطاء التسيير، ورقابة التسيير المتعلقة بصحة ونزاهة الإيرادات والنفقات المبينة في المحاسبات العمومية، تَعززت مستجدات مؤسسية وتنظيمية مهمّة، من خلال ما يلي:
– إعداد تقرير سنوي حول قانون التسوية مرفق برأي حول صدق الحسابات ومطابقتها للأصول القانونية والمالية (المادتان: 32 و68)؛
– تقييم السياسات العمومية (المادة: 5)؛
– تعزيز استقلالية المحكمة في إعداد برنامجها السنوي للأنشطة (المادة: 21)؛
– إنشاء غرفة ثالثة مخصّصة للمفوضيات والوكالات والسلطات ومشاريع الاستثمار العمومي (المادة: 7 من المرسوم رقم: 2022 – 107 المطبق للقانون العضوي رقم: 2018 – 032)؛
– توسيع حق الاتصال والاطلاع ليشمل الأنظمة المعلوماتية والبيانات الرقمية؛
– تعزيز الضمانات الإجرائية المتعلقة بحق رد التفتيش في حال التشكيك في تجرد أحد أعضاء المحكمة، وكذا حق القاضي المنتدب في طلب الإعفاء من المسؤولية عند قيام سبب يُحتمل أن يمس حياده أو استقلاله، وهي ضمانات تُكرس استقلال القاضي وتضمن نزاهة المسار الرقابي (المادة: 21).
وبناء على ذلك، يأتي التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023 في مرحلة تشهد فيها هذه الأخيرة توسعا في صلاحياتها وتحديثا لإطارها القانوني والتنظيمي، ما يجعلها حلقة محورية في منظومة الرقابة الوطنية من خلال مواكبتها للتنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية (LOLF) وللإصلاحات الهيكلية المتفرعة عنه.
وعشية دخول ميزانية البرامج حيز التنفيذ سنة 2026، يكتسي دور المحكمة أهمية خاصة، إذ يُنتظر منها أن تسهم في ضمان صدقية المعلومات المالية وشفافيتها، وأن تُعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة في إطار مقاربة التسيير المبنية على النتائج المنصوص عليها في القانون العضوي لقوانين المالية.
وفي هذا السياق، تضطلع محكمة الحسابات بـرقابة مزدوجة على الأنظمة المحاسبية العمومية، وفقا لما خولته لها المواد: 15 و32 و68 من القانون العضوي رقم: 2018 – 032، من خلال:
– التحقق من مطابقة المحاسبة الميزانونية لأحكام قانون المالية المصادق عليه؛ و
– تقدير صدقية المحاسبة العامة للدولة، بما يضمن الانسجام بين النظامين المحاسبيين وموثوقية المعلومات المالية العمومية المعروضة أمام البرلمان والرأي العام.
وبذلك، ومن خلال وضع التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023 في سياقه القانوني والمؤسسي المرتبط بالإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المالية العامة وإعادة تعريف الدور المؤسسي للمحكمة، يتبين أن هذا التقرير يُشكل وثيقة مفصلية يُفترض أن تجسد التطبيق الفعلي لمبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة في إدارة المال العام.
غير أنّ قراءة محتواه التحليلي تُبرز أوجه قصور تستوجب التوقف عندها، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، في ضوء متطلبات الدقة والوضوح التي يفرضها الإطار الميزانوي والمحاسبي الجديد، والنصوص القانونية الناظمة للمالية العامة.
II. ملاحظات حول التقرير العام السنوي 2022-2023
في ضوء الإطارين القانوني والمؤسسي المنظمين لتسيير المالية العامة، يُظهر تحليل التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023 جملة من الملاحظات ذات الطابعين الشكلي والتحليلي، تستند إلى النصوص المؤطرة لعمل المحكمة، وإلى أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية (LOLF)، فضلا عن المرجعيات الدولية لتقييم المالية العامة، وفي مقدمتها تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA).
ويمكن تصنيف هذه الملاحظات ضمن محورين أساسيين:
– ملاحظات تتعلق بشكل التقرير وصيغته المنهجية؛
– وملاحظات تتصل بمضمونه التحليلي ومحتواه الفني.
1. الملاحظات المتعلقة بالشكل:
أ. عدم المطابقة الهيكلية:
تنص المادة: 65 من القانون العضوي رقم: 2018 – 032 على أن التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات، الذي تُحدد هيكليته بموجب المادة: 62 من المرسوم رقم: 2022 – 107 المتعلق بطرق تطبيق أحكام القانون العضوي ذاته، يجب أن يتضمن أربعة محاور رئيسية هي:
– المحور المتعلق بالشروط العامة لتنفيذ قوانين المالية وتطور عمليات الخزينة؛
– المحور الذي يعرض الملاحظات والمقترحات المرتبطة بالعمليات المالية للدولة والمجموعات الإقليمية والمؤسسات العمومية الإدارية؛
– المحور المخصص لتسيير المؤسسات العمومية؛
– والمحور الذي يتناول الأجوبة المخصصة لإبلاغات المحكمة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ الإجراءات المعلنة من طرف الوزراء وغيرهم من السلطات المسؤولة.
غير أن التقرير العام السنوي لسنتي 2022 – 2023 جاء منظما على النحو التالي:
– الباب الأول: تنفيذ قوانين المالية لسنتي 2022 و2023؛
– الباب الثاني: رقابة التسيير، ويتضمن:
– الباب الرابع: الأجوبة على إبلاغات المحكمة.
ويُلاحظ أن الباب الثالث، المخصص لـتسيير المؤسسات العمومية، لم يُدرج بشكل مستقل، ويبدو أن محتواه قد أُدمج ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني. وهو ما يمثل إخلالا شكليا بالبنية المنصوص عليها في المرسوم، مما يُضعف الوضوح البنيوي والتناسق الموضوعي للتقرير، ويحد من قابليته للقراءة والتحليل المقارن وفق التصنيف المعتمد بمرسوم.
ب) التأخر في النشر
كان من المُفترض أن يُنشر التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023 قبل نهاية السنة المالية التالية، وذلك طبقا لأحكام المادة: 67 من القانون العضوي رقم: 2018 – 032 المشار إليه أعلاه. غير أنّ نشره لم يتم إلا بتاريخ: 8 أكتوبر 2025، أي بعد ما يقارب عامين إلى ثلاثة أعوام من التأخير.
ويمثل هذا التأخر إخلالا بالجدول الزمني القانوني للنشر، ويُضعف مبدأ الدورية المنتظمة الذي يُفترض أن يطبع عمل المحكمة، كما يؤثر سلبا على الطابع الآني والعملي للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، ويحد من فاعليته كأداة للشفافية والمساءلة في تسيير المال العام.
ج) غياب عمليات رقابة المتابعة:
تنص المادة: 67 من القانون العضوي رقم: 2018 – 032 على أن «تتأكد المحكمة من تنفيذ التوصيات التي تصدرها في تقاريرها السابقة بواسطة عمليات رقابة المتابعة وتنشر نتائج هذه العمليات الرقابية في التقرير السنوي«.
غير أن التقرير خلا تماما من أي إشارة إلى عمليات رقابة المتابعة أو إلى نتائج تنفيذ التوصيات السابقة، في مخالفة صريحة لأحكام هذه المادة.
ويُعدّ هذا الإغفال مخالفة شكلية تُضعف قابلية التتبع والتقييم الدوري للتقدم المحرز في تنفيذ توصيات المحكمة، كما تحد من القدرة على قياس الأثر الفعلي لعملها الرقابي.
د) غياب معايير لاختيار الكيانات الخاضعة للرقابة:
لم يُبين التقرير المعايير المعتمدة في اختيار الكيانات موضوع الرقابة، الأمر الذي يُضعف وضوح منهجية العمل ويحد من إمكانية تقييم منطق البرمجة الرقابية.
كما يُلاحظ وجود تركيز مفرط في عمليات التدقيق على بعض الكيانات التي خضعت للرقابة عدة مرات متتالية، في مقابل غياب أي تدقيق سابق لدى كيانات أخرى، رغم خضوعها لنفس الالتزامات القانونية في مجال التسيير المالي.
وتُبرز هذه الملاحظة اختلالا في التخطيط الرقابي وغياب رؤية قائمة على مبدأي العدالة والتغطية المتوازنة للرقابة، وهو ما يتنافى مع متطلبات الشفافية والإنصاف المؤسسي التي تقوم عليها مهام محكمة الحسابات في مراقبة المال العام.
هـ) غياب المعلومات المتعلقة بوسائل المحكمة في التقرير العام:
لا تنص النصوص المنظمة لمحكمة الحسابات صراحة على إلزامية إدراج المعطيات المتعلقة بوسائلها البشرية والمالية ضمن التقرير العام السنوي، رغم أن هذه المعطيات تمثل عنصرا أساسيا لتقدير قدرات المحكمة المؤسسية ومدى كفاءتها في أداء مهامها.
ومع ذلك، خلا التقرير من أي بيانات تتعلق بالموارد البشرية أو المالية، رغم إمكانية تتبّع تطورها من خلال قوانين المالية السنوية، ورغم أن تقييمات PEFA للأعوام 2014 و2020 و2025 أشارت مرارا إلى ضعف في الموارد البشرية والمادية للمحكمة.
ويُذكر أن ميزانية المحكمة ارتفعت بشكل ملحوظ من 45 مليون أوقية جديدة سنة 2020 إلى 116 مليون أوقية جديدة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 158%، كما تم تعزيز طاقم القضاة المنتدبين عبر أربع دفعات توظيف: 5 سنة 2015، و6 سنة 2019، و5 سنة 2021، و9 سنة 2022.
إن غياب هذه المعلومات عن التقرير لا يتيح تقييم مدى التناسب بين الموارد المعبّأة والنتائج المحققة، كما لا يسمح بقياس كفاءة المحكمة في الاضطلاع بمهامها الرقابية.
وعليه، فإن صمت التقرير عن موارد المحكمة يُعد إخلالا شكليا مؤثرا يمس شفافيتها ومصداقيتها، كما يحد من قيمة التقرير نفسه.
2. الملاحظات المتعلقة بجوهر التقرير:
أ. غلبة الوصف على حساب التحليل:
يتسم التقرير بطابع وصفي عام يغلب عليه العرض السردي للوقائع أكثر من التحليل والتقييم، إذ تبقى قيمته التحليلية والتقويمية محدودة.
فالملاحظات الواردة فيه، على الرغم من أهميتها، تظل عامة وغير مدعومة بما يكفي من الأدلة أو التحليل المقارن، ولا تُبرز على نحو كاف الأسباب البنيوية للاختلالات المرصودة ولا انعكاساتها الملموسة على أداء التسيير العمومي.
أما التوصيات التي خلص إليها التقرير، فتبدو مجزأة وضعيفة الارتباط بالملاحظات المعروضة، ما يعكس نقصا في الاتساق المنهجي وغيابا لدمج فعلي لمنطق التقييم السياسات العمومية القائم على النتائج المنصوص عليه في المادة: 5 من القانون العضوي رقم: 2018 – 032 المتعلق بمحكمة الحسابات.
وبذلك، يفقد التقرير جانبا من دوره كأداة للتقييم المؤسسي والتحليل البنيوي لأداء المالية العامة، ويظهر أقرب إلى تقرير رصدي منه إلى تقريرٍ تقويمي موجه لدعم القرار والإصلاح المالي.
كما يُلاحظ أيضا أن التقرير يفتقر إلى التحليل النقدي والمقارنة المنهجية، وإلى صياغة واضحة للاستنتاجات، وهي عناصر تُشكل جوهر العمل الرقابي والتقييمي.
فغياب جهد تحليلي فعلي في التفسير والاستنتاج حال دون بلورة تقييم مهني موضوعي يستند إلى تحليل متكامل للمعطيات، ويُسهم في تنـوير الرأي العام وصناع القرار حول كيفية تسيير المال العام واستعماله ومدى كفاءته في تحقيق الأهداف المعلنة للسياسات العمومية.
ب) عدم الدقة في إسناد المسؤوليات
تُظهر الملاحظات المستخلصة من مهام الرقابة أن المحكمة تميل إلى إسناد المسؤولية بشكلٍ عام إلى من تصفهم بـ”المسيرين” دون تمييز واضح بين مستويات الصلاحيات أو تحديد دقيق للوظائف المختلفة للمتدخلين في سلسلة الإنفاق العام.
ويُعد هذا النهج مجافيا للواقع المؤسسي المعقد لتسيير المالية العامة، والذي يتسم بتعدد المتدخلين وتنوع مستويات المسؤولية، لاسيما منذ بدأ مسلسل اللا محورية التدريجية لوظائف الأمر بالصرف والدفع(la déconcentration progressive des fonctions d’ordonnancement et de paiement) الذي بدأ بالمرسوم رقم: 2006 – 049 الذي أنهى مبدأ وحدة الآمر بالصرف ووحدة المحاسب العمومي، وتواصل مع المرسوم رقم: 2019 – 186 (المادة: 102) الذي كرّس لا محورية الدفع على المستوى الوزاري، ثم تعزز بالمقرر رقم: 244/2020/MF المعدل للمقرر رقم: 2294/2015/MF لتوسيع نطاق هذه اللا محورية إلى البعثات الدبلوماسية والمصالح الجهوية.
ويؤكد مبدأ الفصل بين وظائف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، المنصوص عليه في المادة: 63 من القانون العضوي رقم: 2018 – 039 المتعلق بقوانين المالية (LOLF)، ضرورةَ التمييز بين المرحلة الإدارية (الأمر بالصرف) والمرحلة المحاسبية (الرقابة القبلية والدفع)، إذ يتحمل كل طرف مسؤولية قانونية حصرية عن أعماله ضمن نطاق اختصاصه.
وبمقتضى هذا المبدأ، يظل الوزراء هم الآمرون بالصرف الرئيسيون للاعتمادات المدرجة في ميزانياتهم (المادة: 61 من القانون العضوي)، في حين لا يتمتع الأمناء العامون إلا بتفويض توقيع لا يُرتب أثرا ناقلا للاختصاص وفقا للمرسوم رقم: 2010 – 066، الأمر الذي يستوجب ضبط مستويات المسؤولية بدقة، إذ لا يُعفي التفويض الوزير من مسؤوليته الأصلية.
كما أن التقرير لم يحدد موقع الهيئات الأساسية المعنية بالصفقات العمومية، رغم أن صلاحياتها تُعد حاسمة في تحديد المسؤوليات، ومن أبرزها:
– لجان إبرام الصفقات العمومية (CPMP)، التي تُعنى بتسيير إجراءات إبرام الصفقات التي تفوق العتبات التنظيمية (المادة: 8 من القانون رقم: 2021 – 024 (
– اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية (CNCMP)، المختصة بالرقابة المسبقة على الإجراءات الاستثنائية (المادة: 10 (
– سلطة تنظيم الصفقات العمومية (ARMP)، المكلفة بالتنظيم وتسوية النزاعات وإصدار العقوبات التأديبية (المادة: 12 (
كما غاب أيضا عن التقرير إخضاع مفوضي الحسابات (Commissaires aux Comptes) للمساءلة، وهم المكلّفون بتصديق القوائم المالية وضمان موثوقية المعلومات المحاسبية للهيئات والمؤسسات العمومية، فضلا عن البرامج ذات الطابع الخاص مثل تآزر ومفوضية الأمن الغذائي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (المقرر رقم: 819/2000/MF/DTEP ).
إن إغفال التقرير تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف ضمن نطاق اختصاصه يُضعف سلسلة المساءلة، ويُفقد التحليل دقته القانونية، وقد يؤدي إلى تحميل غير المستحقين مسؤولية أو إلى إعفاء المذنبين منها، مما يُقوض المصداقية المؤسسية للمحكمة ويُقلل من الأثر الرقابي لتقاريرها.
وبناء على ذلك، فإن هذا الإغفال المنهجي يُضعف القدرة التقييمية للتقرير ويحد من فاعليته في قياس مدى انسجام منظومة الرقابة والمساءلة الوطنية في تسيير المال العام.
الخلاصة:
على الرغم من وجاهة العديد من الملاحظات التي تضمنها التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022 – 2023، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية، فإن التقرير يُظهر، من حيث الشكل والمضمون، قصورا منهجيا وتحليليا قلّل من مداه المؤسسي وقيمته التقييمية.
كما أن غياب تحميل المسؤوليات بوضوحٍ للفاعلين المعنيين، كلٌّ في نطاق صلاحياته القانونية، أضعف سلسلة المساءلة وأثر على مصداقية المحكمة، إذ يُعد ذلك إخلالا بمبدأ المسؤولية الذي كرّسه القانون العضوي رقم: 2018 – 032.
وبمقتضى المادتين: 66 و67 من القانون نفسه، تضطلع المحكمة بدور أساسي في نشر المعلومة المالية العمومية وإثراء النقاش البرلماني حول تسيير المال العام.
لذلك فإن إعداد تقرير أوفى من حيث المنهج والمضمون من شأنه أن يُعزز المصداقية المؤسسية للمحكمة، ويُرسّخ دورها كركيزة أساسية في نشر المعلومة المالية العمومية وإنارة النقاش الديمقراطي حول تسيير المال العام.