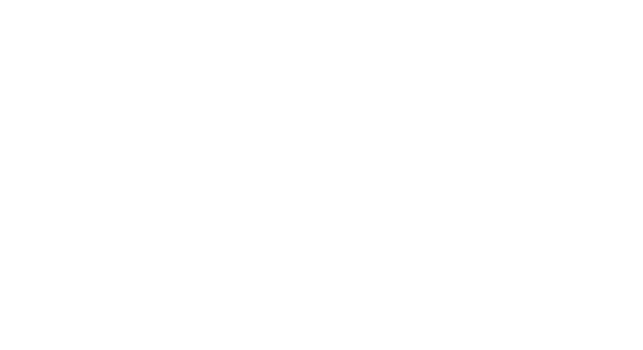جدول المحتويات
فالعملية تتوقف على هذين الأصلين.
فمن البديهي طبعا أن يتقن الأستاذ مادته التي تعهد بتدريسها لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن جهل شيئا يستحيل عليه تبليغه. لكن الجهل نوعان، أحدهما عدم المعرفة وصاحبها لا يستطيع ممارسة أي تعليم، والنوع الثاني من الجهل هو أن يجهل الإنسان المادة، ويحاول استبدالها بغيرها، وهذا أخطر من الأول، لما يتضمن من تزوير وخيانة.
أما من أتقن مادته فعليه أن يعرف أن عملية التبليغ تتطلب معرفة التعليم بصفتها مهمته لها أصولها وقواعدها وطرقها.
الأصل الأول: إحكام المادة:
لا شك أن أول أصولها هو إحكام المادة التي على الأستاذ تدريسها. وإحكامها لا يعني عملية الحفظ التي سنتحدث عنها فيما بعد، ولكن يعني ما يسمى بـ"معرفتها بالقوة" وإلى هذا يشير الأصوليون في شروط الاجتهاد. ومعناه أن الأستاذ يحكم قواعد المادة الأساسية ، وأنه قد درس مقرراتها واستوعب فهمها وأطلع على مراجعها الموثوقة، وعرف كيفية استثمارها.
وإن من أصول مبادئ التربية الصدق والإخلاص؛ ذلك أن التربية أمانة ورسالة، وقد صدق الشاعر في قوله :
كاد المعلم أن يكون رسولا.
والأمانة تقتضي أن يكون صادقا في عمله، مخلصا في نيته، متمثلا أن رسالته تتطلب منه أن يقوم بأمرين أثنين: أحدهما تبليغ المعلومات المطلوبة على أحسن الوجوه وأوضحها وأقربها. الثانية أن يكون قدوة في سلوكه المعرفي؛ فمن الناحية العملية فالمطلوب منه في أثناء التبليغ أن يحسن الاختيار في نطاق برنامجه، وأن لا ينسب لنفسه ما ليس له، بل عليه أن يعترف لكل ذي حق بحقه.
كما تقتضي هذه الأمانة أن لا يتبع هواه في تبليغ المعرفة أو يقتصر على ما وافق طبعه، أو يخفي ما يخالف رأيه.
وهذه الأمور تبدو في معالجة مسائل الخلاف في المواد المقررة ومن المأثور عن الإمام الشافعي قوله: أعتقد أن رأيي صواب يحتمل الخطأ وأن رأي خصمي خطأ يحتمل الصواب. ومما روي أنه ناظر أحدا من الفقهاء في قضية وكل منهما رجع عن رأيه، وبقي الخلاف بينهما، إذ كل منها تبنى رأي الآخر.
ويقول العلامة محنض ابن اعبيد:
ليس من أخطأ الصواب بمخط
إن يعدلا ولا عليه ملامه
إنما المخطئ المسيء الذي إن
ظهر الحق لج يحمي كلامه
التواضع:
ومن هذه الأصول كذلك التواضع، وهو من أخلاق العلماء وسلوك المربين. ويقتضي في مجال التعليم أن يقتنع الأستاذ أن ليس في استطاعته أن يعلم كل شيء، وأن يتذكر أن "لا أدري" هي نصف العلم وإن لم يتجنبها أصيبت مقاتله، وأن لا عيب في الاعتراف بجهل قضية معينة، وإنما العيب في إدعاء علم ما لا نعلم. ومما يروى أن الإمام مالك سأله شخص عن حكم نازلة فقال له "لا أعرف عنها شيئا" فرد عليه المستفتي يقول: "إني جئتك من بعيد على ثقة أنك سوف تخبرني بهذا الحكم". فقال له الإمام مالك: "إذا عدت إلى أهلك فقل لهم: مالك قال إنه لا يعرف حكم مسألتك".
ويذكر أن العلامة الشيخ محمد فال بن محمذن بن أحمد بن العاقل كان يقول لطلبته لنضع النص بين أيدينا، فقد أفهمه فبلكم وقد تفهمونه قبلي و يمكن أن نفهمه معا في آن واحد.
فالتواضع جزء من الصدق، والصدق مفتاح النجاح الضروري لتأكيد الثقة بين الطالب والأستاذ وسنرى أن قاعدة تهيئ الدروس قد تحد من المواقف المحرجة التي يمكن أن تعترض المعلم في علمه، لكن ليس في استطاعته أن يعرف جميع المسائل التي قد تتفرع عن درسه، أو عن أسئلة الطلبة عن تفاصيل بعض الأمور التي لا يستحضرها؛ وعند ذلك فسلاحه الأجدى هو التواضع والصدق.
القواعد:
وبما أن للتربية العملية مبادئها وأصولها التي ذكرنا فإن لها أيضا قواعد عملية من الضروري أن يطبقها الأستاذ في درسه.
القاعدة الأولى: تجنب الارتجال في الدرس
على الأستاذ أن لا يترك مجالا في الدرس للفراغ والانحراف: ولذلك فعليه السعي في ملء وقت التبليغ، بمطابقة بين الزمن المحدد له وبين المادة التي يتلقاها الطلبة.
ويتم هذا التوافق بين الزمن والموضوع فيما يعرف بتهيئ الدرس. ومن الضروري أن يكون هذا التهيؤ مسطرا ومنظما، ويضع الأستاذ عناصره أمامه بعد ما أحكم المناسبة بين كمها وزمنها فالاعتماد الصرف على الذاكرة قد يؤدي إلى الارتجال المخل بالدرس.
يبدأ التهيؤ والعرض على أربع مراحل:
1. عنوان الدرس، وبيان وضعه أي ترتيبه في نطاق المقرر العام وصلته بما قبله إن لم يكن الدرس الأول الذي ينبغي أن يخصص لتقديم المقرر عموما، وهو درس خاص وحاسم في علاقة الأستاذ بطلبته.
2. المرحلة الثانية: حصر عناصر الدرس، وذكرها في ترتيبها المنهجي وسنبين بعض هذا التفاصيل في بعض النماذج المخصصة لطرق التدريس.
3. بدء العرض وفقا للطريقة التي يقرر الأستاذ اعتمادها في دروسه بحيث لا يتجاوز قضية إلا بعد التأكد من استيعاب الطلبة لها. ومن لواحق هذه القاعدة عدم التسرع في الإلقاء والتأني والصبر على ما قد يلاحظه من البطء في تفهم الدرس.
4. استعمال طريقة يدرك فيها الأستاذ نتائج الدرس.
القاعدة الثانية: التوضيح
القاعدة الثانية في التربية هي توضيح مادة الدرس، وهي عملية تبادل بين الأستاذ والطالب أي بين المخاطِب والمتلقي . وهذا التوضيح يعتمد على وسيلتين إحداهما الإلقاء الشفهي، والذي يحتل المكانة الأولى في الدرس: فلذلك يتطلب من الأستاذ بذل جهد خاص في نوعية خطابه بانتقاء لغته، ولكل مادة لغتها، واختيار مكان يتضح فيه سماع كلامه؛ وترتيب عرضه، وتنويع صيغ الإلقاء بالتمثيل والمشاركة حتى يتفادى الرتابة التي لا يتم معها الإصغاء.
والوسيلة الثانية تتمثل في استعمال ما يسمى بوسائل الإيضاح الفنية والتقنية وقد تكون مهمة للإلقاء الشفهي الذي يقتصر على حاسة السمع، وبما أن الدرس لا يتم إلا بالفهم والحفظ فإن اشتراك البصر في عملية العرض قد يعين على هذين الهدفين، غير أن استعمال هذه الوسائل يتطلب مهارة خاصة في حسن استعمالها فغالبا ما يتطلب تجهيزها، وتنظيمها وقتا ضائعا من فترة الدرس .
كما أنها تحتاج إلى توفر الطاقة الكهربائية لعرض النصوص أو الصور على شاشة الدرس.
وعلى كل حال فإن توضيح الدرس ينبغي أن يناسب طبيعة المادة المدروسة ومستوى طور مسلك الدراسة فإذا كان التعليم في طور السلك الأول من التعليم العالي فإنه قد يحتاج إلى شكل من التلقين ، فإن التعليم في الدراسات العليا يعتمد أساسا على مناهج البحث ولهذا فإن استعمال الكتاب قد يكون من أنجع وسائل الإيضاح إذا ما توفرت شروط استعماله العملية.
وقد يقع التساؤل في هذا الصدد عن دور "المذكرات" وفوائدها، وعن وقت تقديمها قبل الدرس أو بعده، وفي هذا المجال لا يوجد في رأيي رأي جاهز فذلك من القضايا التي للأستاذ فيها حرية الاجتهاد وفقا لتجربته وخبرته.
القاعدة الثالثة: التقويم
التقويم من أهم قواعد التربية، إذ بواسطته يستطيع الأستاذ أن يعرف جدوى عمله. فقد رأينا أنه يحمل أمانة وأن عليه أن يؤدي رسالة ، فمن الواجب عليه أن يتأكد أنه بلغها وإنها وصلت بالصورة المرضية.
وإن في إمكان الأستاذ أن يُقدِّر مدى تجاوب الطلبة مع الإلقاء وانتباههم للموضوع واستيعابهم لمحتواه. ولكن ليس يكفي في هذا الاعتماد على الملاحظات العامة . فلابد من استعمال وسائل مباشرة تؤكد ما يظهر من الملاحظات.
وأبسط هذه الوسائل هو استفسار الطلبة عما فهموه وطلب بيان ما ادعوه لأن فهم المادة لا يقتصر على تصورها الذهني فالبرهان الحقيقي على فهمها يتمثل في القدرة على التعبير عنها بجلاء. واستكمال معرفة الشيء في وضوح التعبير عنه . وهذا ما عبّر عنه أحد النقاد بقوله: وإن من عرف المعاني حق معرفتها أتته الألفاظ طائعة ، فسهلت عباراته ووضحت خطاباته.
وهذه الإستفسارات قد تكون أثناء الدرس، كما يمكن للأستاذ أن يخصص جزءا من الوقت في آخر الدرس للأمثلة حول موضوع الدرس وبيان ما استشكل منه في مراجعة لغوامضه وبعض الأساتذة يؤجل عملية الاستفسار لبداية الدرس الموالي، ولكل أستاذ منهجه وطريقته في تطبيق هذه القاعدة والمهم هو التأكد من النتيجة بغض النظر عن الطرق المستعملة.
طرق التدريس:
1. التشويق
وهو من أهم طرق التدريس لأنه يهدف إلى استنهاض فكر المتعلم، ليتم استمرار إصغائه، وتطلعه إلى المعارف المقدمة إليه في الدرس وفيما بعد الدرس.
ذلك أن العلوم الإسلامية منها ما هو مترابط إجمالا، ومنها ما تترابط بعض أجزائه. فالمترابط جزئيا قد يمكن استصحاب بعض أجزائه دون بعض، ففي إمكان الذي يدرس النحو مثلا أن يعرف أحكام المعرب والمبني إذ لا ارتباط بينها وبين الإخبار بالذي وفروعه ، وإن كان تفهم أحكام المبتدإ مرتبط بأحكام الخبر.
أما العلوم التي ترتبط ارتباطا كليا مثل أصول الفقه فلن يستطيع المتعلم إتقانها إلا من بعد دراستها كلا، إذ يستحيل التمكن من مادة القياس الأصولي دون معرفة ما سبقه من مباحث القرآن والسنة.
ومن أجل ذلك فإن عملية التشويق تقتضي أن يقدم الأستاذ للمتعلمين صورة إجمالية عن المادة، ثم يقوم بتفصيلها مبينا أنه في كل درس يقطع شوطا في الوصول إلى الهدف النهائي.
وهذا الهدف النهائي ينبغي أن يبقى ماثلا في ذهن المتعلم الذي يعرف أنه في رحلة فكرية ويريد أن يصل إلى نهاية الرحلة.
2. الحفظ
حفظ المتون العلمية من أهم ميزات التربية الإسلامية عموما، ومن خصائص التعليم الإسلامي في المحاضر الشنقيطية، فقديما كان علماء الإسلام حفظة بارزين، حتى في العهد النبوي إذ قيل إن عائشة أم المؤمنين كانت تحفظ أكثر من ألف قصيدة من الشعر، وفي عهد التابعين ذكر أن ابن شهاب الزهري كان يملي من حفظه مائة ألف حديث، وكان الشافعي يقول:
علمي معي أينما يممت يتبعني
قلبي وعاء له لا جوف صندوق
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي
أو كنت في السوق كان العلم في السوق
أما علماء الشناقطة فقد اشتهروا بالحفظ، وقد ساعدهم على ذلك تعميم حفظ القرآن في الصغر مما يقوي الذاكرة، ثم كانوا يدرسون في ظروف ليست فيها وسائل الإنارة، فاعتادوا "التكرار" ليلا والاستظهار نهارا، حتى أن بعض المعاصرين عابهم بالحفظ، معتقدا أن عملية الحفظ تنافي الفهم والتعقل، وهذا على مذهب الفرنسي مونتي الذي قال إنه يفضل الرأس المتعقل على الهامة المليئة.
ولكنا ينبغي أن نعرف أن الرأس "الفارغ" لا يمكنه أن يكون متعقلا، فلابد إذا للأستاذ من الموازنة بين الحفظ والتفهم، كما في إمكانه الاستعانة بالرموز التي تعين الذاكرة مثل استعمال رؤوس الحروف وضبط الأسماء.
ومن هذا النوع ما يستخدمه أهل علم الفرائض في قولهم هبأ دبز
وفي ضبط أهل السهام.
3. المشاركة
ومن طرق التدريس الطريق المستعملة في مشاركة الطالب مع الأستاذ في عرض الدرس، وهي تضفي حيوية على الدرس، وتزيد في اهتمام الطلبة، كما تبين للأستاذ مدى انتباه الطلبة، ومستوى خبراتهم وذكائهم.
وهذه المشاركة تأتي عن طريق المحاورة، وهي قديمة وتعرف بالطريقة السقراطية، ويذكر أن أفلاطون، تلميذ سقراط كان يعتقد أن الأرواح قبل بروزها للوجود قد اتصلت بالمصدر الإلهي للمعارف، واختزنتها في الأذهان، وأن التعليم إنما هو تذكر لتلك المعارف القديمة.
ولسنا بصدد مناقشة هذا الاعتقاد، مع أنا نعلم أن الله تعالى قد علّم آدم الأسماء كلها، وأنه قد أخذ عليه العهد ونسي، وأنه سبحانه خاطب الأرواح بقوله ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾، والمهم في هذا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلّمه البيان وأعطاه ملكة تعقل المعلومات وحفظها.
ولنعد إلى جدوى هذه الطريقة بالقول بأنها قد تفيد في بعض المواد التي يسهل فيها الاستنباط، وفي التأكد من فهم مضامين الدرس، غير أنها قد لا تفيد في المسائل التي يجهلها الطلاب، وغير قابلة لوسائل الاستنتاج أو التعليل، وهي لا تدر ك إلا بالتلقين، لكن إحكام القواعد العامة يسهل على الطالب أن يتعقل المقارنة والقياس ويستخرج الجزئيات من القواعد العامة.
دروس علوم القرآن:
علينا قبل كل شيء أن نبين للأستاذ أن دراسة علوم القرآن تتطلب سلوكا خاصا، واستعدادا كاملا يناسب مكانة هذه المادة التي تتناول كلام الله عز وجل، فبعض علماء الحديث يقول إن من في بيته كتاب سنن أبي داود فإن معه نبي يتكلم، وما هو الأمر حينما يستمع المؤمن إلى خطاب ذي العزة والجلال.
بعد هذا الاستعداد النفسي يحق لأستاذ علوم القرآن أن يبدأ مع طلبته في دروس يجب أن تتم في خشوع لنطق الكلام عن الكلام القدسي.
وعلوم القرآن لا يمكن حصرها لقوله تعالى ﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلامات ربي ولو جئنا بمثله مددا﴾ وقد أحصى السيوطي في كتاب الإتقان من هذه العلوم نحوا من ثمانين نوعا.
وإذا ما أردنا أن نقدم نموذجا من هذه الدروس فيمكننا أن نختار مثالا من دروس التفسير نحوا من ثمانين نوعا.
وليعرف الأستاذ أنه ليس بمفسر وإنما هو مبلغ أقوال المفسرين. والمفسرون اتبعوا في مناهجهم اختصاصات متنوعة، فمنهم من جاء بتفسير شامل يتناول المأثور والتأويل، مثل تفسير الطبري قديما، وابن عاشور حديثا، ومنهم من اهتم بالأحكام مثل القرطبي، أو اللغة والنحو مثل ابن حبان الغرناطي، ومنهم من أبرز الجانب البلاغي مثل الزمخشري في الكشاف.
والمطلوب من أستاذ التفسير أن يراجع في تهيئ درسه أقوال هؤلاء المفسرين وأن يقدم منها ما يرى أن طلبته عندهم القدرة الذهنية على استيعابه وفقا لقاعدتين تحدثنا عنهما سابقا، وهما ضرورة تهيئة الدرس والتساؤل مع إلقائه ما ذا الذي تحصل عند الطلبة بعد إنهاء الدرس.
درس الحديث:
في هذا الدرس ينبغي للأستاذ أن لا يمل من تكرار أبجدية علوم الحديث ليرسخ في أذهان الطلبة أن الحديث هو بيان القرآن، فالكتاب العزيز أعطى الشريعة جملة فبينت السنة تفاصيلها وفسرت المجمل، وربما قيدت المطلق، وخصصت العام، ومن أبجديات هذا العلم معرفة الفرق بين مصطلح السنة والحديث على التقدير أن بينهما فرقا، ومنها كذلك معرفة اصطلاحات الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ومعرفة مشاهير الرواة والمدونات والتذكير بخصائص منهج أهل الحديث الصارم المعتمد على نظرية الإسناد الذي لولاه لقال من شاء ما شاء.
فإذا كان الدرس يخص مصطلح الحديث فإن على الأستاذ أن يبيّن مراجعه الأساسية مثل مقدمة ابن الصلاح، وألفية العراقي، وكتب الخطيب البغدادي وابن حجر والسيوطي وابن الحاج إبراهيم الشنقيطي، كل هذه المعلومات من ثقافة الفن، ولكل فن ثقافته.
أما إذا كان الدرس يتناول نصوص الحديث، فإني أوصي الأستاذ باختيار أربعين حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من محفوظات الطلبة، وأن يتم اختيار الأحاديث التي قلت ألفاظها وكثرت معانيها، ونعطي منها الأمثلة التالية:
– إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
– الصلاة عماد الدين
– الصوم لي وأنا أجازيه
– ما نقص مال من صدقة
– من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه
– لا ضرر ولا ضرار
– الإثم ما حاك في الصدر
– استفت قلبك
– الحياء من الإيمان
– مطل الغني ظلم
– الضمان بالخراج
– الجنة تحت أقدام الأمهات
– احفظ الله يحفظك
وهذا النوع من الأحاديث كثير جدا ومفيد جدا، ومنه يستضيء الطالب بنور الحكمة.
درس أصول الفقه:
دروس أصول الفقه تتناول مادة من أصعب مواد الدراسات الإسلامية لأن تداخل مواضيعها يحول دون استيعاب جزئياتها، فلن يتمكن الطالب من معرفتها حق المعرفة حتى يستكمل دراسة جميع أبوابها، كما أنها تتطلب إلماما بمجموعة من العلوم التي ليست من صلبها، فالطالب فيها يدرس مباحث القرآن الكريم وأصول القراءات، وقضايا لغوية تتعلق بالمنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والتعريض والكناية.
كما عليه أن يدرس قبل ذلك أنواع الأحكام وأسس المعرفة وكل هذه مسائل من المنطق وعلوم المعاني والبيان، وهذه المسائل أيضا تتدرج في دراسة السنة مع أن لها كذلك قواعدها وضوابطها في فن المصطلح وضوابط الرواية، كل هذا يهدف إلى تمكين الطالب من فهم استثمار الأصوليين الأولين للقرآن والسنة.
وحينما يصل الدارس إلى مباحث القياس والاجتهاد، فإن الأمر يزداد تعقيدا وصعوبة والتنبيه على هذه الصعوبات يرمي إلى تنبيه الأستاذ والطالب على دقة المهمة في تدريس هذه المادة.
واعتقد أن من بين الوسائل التي تجعل الأستاذ يجاوز هذه العقبات أن يعتمد على مرجع واحد أولا، يبين للطلبة مضامينه إجمالا، ثم يبذل ما أمكنه من الجهد في تبسيط الموضوع حتى يتيقن أن الطلبة تشبعوا من روح المادة، وفهموا فكرها ولبّها، وعرفوا قواعدها الأولية، فحينئذ يمكن للأستاذ أن يتوسع في الحديث عن ثقافة المادة وعن روافدها وتاريخها، واختلاف المذاهب فيها، ومناهج البحث فيها.
ومن المهم أن يدرك الطلبة دور هذه المادة في فهم مقاصد الشريعة الإسلامية وفيما يتعبد الله به عباده من أحكام تتعلق بحقه تعالى وبسلوك المسلم في حياته الخاصة ومسؤولياته تجاه أمته.
دروس علوم اللغة:
دروس علوم اللغة كمثل كل الدروس، تتطلب استعدادا وتركيزا لسببين اثنين أحدهما أهمية اللغة في الحياة الفكرية والتربوية، فبها نتعلم وبها نُعلم. ثانيهما أن كثيرا من الأساتذة لا يقدرون دورها في عملية التبليغ، ومنهم من يعتقد أن دراستها أمر ثانوي بالنسبة لدارس العلوم مع أن كثيرا من اخفاقات الطلبة في العلوم ناتج من ضعفهم في اللغة.
وعلوم اللغة متنوعة، ففيها تدرس اللغة بصفتها مادة مستقلة، فيصبح البحث في أصولها وقواعدها مثل ما يوجد في خصائص ابن جني ومزهر السيوطي، ومن موادها المستقلة الدراسات النحوية ومتونها كثيرة، وقد أضاف لها المحدثون الدراسات اللسانية وتعتبر الآداب من موادها الرئيسية.
ولكل من هذه الفروع طرق للتدريس تلائم طبيعتها، غير أن الأهم في مجال موضوعنا اليوم أن نتفق على جملة من المبادئ العامة فيما يخص تعليم اللغة.
1) أن لا يفرق الأستاذ بين تدريس مادته الخاصة، أيا ما كانت، وبين لغة تلك المادة، حريصا على سلامة اللغة ومنبها على أحكامها وغوامضها، وذلك في الدراسات الإسلامية والقانونية والاقتصادية.
2) أن تكون لغة التدريس عربية صحيحة، ولو كانت مبسطة، دون اللجوء إلى اللهجة العامة، وهذا يتطلب من الأستاذ اهتماما خاصا باللغة التي يدرس بها.
3) البحث في طريق تدريس كل مادة من فروع اللغة، ففي النحو مثلا يمكن أن يراعي "أدبيات" نحو ابن مالك، والتنبيه على تأثيرها على ثقافة المجتمع، وفي الأدب فإن من واجب الأستاذ أن يتمثل نظرة عموم المثقفين إلى بلاد مليون شاعر.
4) تدريب الطلبة على استعمال لغة سليمة وحثهم على القراءة التي هي أساس تغذية ملكاتهم في التعبير كتابيا أو شفويا.
خاتمة
أود أخيرا أن أبين أنا في تقديم هذه الورقة حول التعليم لا نسعى إلى الحدّ من حرية الأستاذ في تصرفه التربوي، فللأستاذ كامل السيادة في التحكم في عمله، وإنما نهدف فقط إلى إبداء آراء عامة، نرجو أن تعين المربي في التصرف حسب اجتهاده.
وقد اخترت أن تكون عملية تناول تطبيق ممارسة التربية، اعتمادا على الأسس الحديثة واستنادا على تجربة المحضرة الشنقيطية التي نجحت في الحفاظ على الثقافة في ربوع صحراوية وفي ظروف متقلبة واخترعت منهجا تربويا يتسم بالحرية، فالطالب فيه يختار ما يقرأ ومتى يقرأ. وبالتعاون العلمي بين الطلبة الذين يشكلون "دولة" بينهم في التبادل و"التكرار".
وبالاندماج في المجتمع، حيث يقوم الحي الذي تقع فيه المحضرة بدعمها ماديا ومعنويا، وفق تقاليد معروفة.
وبالسعي في بث روح من التعاون والتوادد من خلال أنشطة ثقافية لا تخلو من المرح والمتعة، يروح بها الطالب من عناء الدراسة الشاقة.
فهذا النموذج المحضري هو الذي نحاول نقله إلى الدراسات الحديثة للجمع بين الأصالة والمعاصرة واقتباس الأحسن والأجدى في كل منهما.
والله الموفق وإليه قصد السبيل.